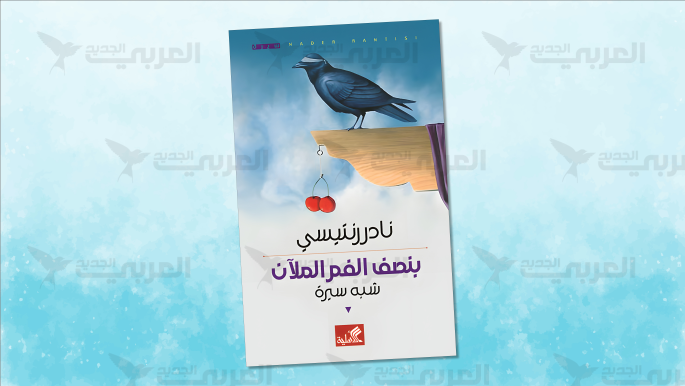كيف نشفى من حب تونس
“ليس سوى متسلق” هكذا وصف معلّق، في إحدى الحلقات الحوارية الفرنسية، ما قام به النائب بالبرلمان الفرنسي سيبستيان ديلوغو، المنتمي لحركة فرنسا الأبية، وأحد الوجوه السياسية الشابة المساندة للقضية الفلسطينية اليوم في فرنسا.
هذا اللقاء، الذي تم قبل أيام قليلة، لم يكن سوى حلقة أخرى من حلقات التفاعل المستمر مع ما نشره النائب على حساباته في مواقع التواصل، يوم 16 آب/آب الماضي، عندما نشَر صورة وشم، اختاره في آخر أيام رحلته لتونس، ليضعه على ربلة ساقه: خريطة تونس وخريطة فلسطين التاريخية وسطهما بيت شعر للفلسطيني محمود درويش هو “كيف نشفى من حب تونس”. لم يكن ديلوغو، آخر من يتكئ على هذا البيت للتعبير عن خليط من المشاعر والصلات بين فلسطين وتونس، إذ أمسى هذا المقطع عنواناً لثلاثين عاماً من العلاقات التونسية مع الهياكل الفلسطينية، وشعاراً وربما سقفاً للتضامن الرسمي مع هذه القضية.
ألقى درويش القصيدة الكاملة الحاملة للاسم نفسه في اجتماع واسع بالمسرح البلدي بالعاصمة التونسية في أيار/أيار 1994. عشية عودة كوادر ومثقفي منظمة التحرير إلى غزة، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، عقب اتفاقية أوسلو، بعد مرور اثنتي عشرة سنة، أمضتها المنظمة في مقرها التونسي، منذ خروجها من بيروت المحاصرة سنة 1982 أثناء الحرب الأهلية. عايش درويش الخُروجَيْن، ومع كل خروج تفاقم حزنه. في بيروت عاين درويش، خروج الفلسطينيين اضطراراً، من أرض تلوح في أفقها فلسطين، إلى أرض بعيدة، وراء البحار ومعها يصبح الحلم الفلسطيني أبعد. هذه المشاعر خلّدها درويش في أول نصوصه المخصصة لهذه المرحلة عندما كتب في قصيدته نزل على البحر: “لم نأتِ كي نأتي… رمانا البحرُ في قرطاجَ أصدافاً ونجمة”.
عادت القصيدة في زخم هذه الأحداث لتعبر عن رفض الإبادة
غير أن قرار العودة في النهاية، أعاد لدرويش نفس المشاعر، ولكن مع اختلاف في الطريقة هذه المرة. وعن ذلك كتب الكاتب أحمد نظيف “كان وداعه لتونس مغموساً في مرارة مصير الثورة الفلسطينية”، إذ لم يكن درويش مقتنعاً بالنتائج التي آل إليها مسار المفاوضات في أوسلو، وفي زيارة لتونس، قبل إلقاء القصيدة بفترة قصيرة، قدّم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومع ذلك، فقد كتم ذلك دون التصريح به علناً، على الأقل في علاقته مع التونسيين. بل على العكس من ذلك قدّم قصيدته، هدية للبلد الذي غادره الفلسطينيون طوعاً، عبر المطارات، لا تحت نيران المدافع أو الحصار: “لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر/ لذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان آخر/ نقفز من حضنها إلى موطئ القدم الأول/ في ساحة الوطن الخلفية”.
وسط حماس الجماهير، قطع درويش القصيدة باكياً. وما إن أنهى الإلقاء، حتى أمست القصيدة رمزاً للوداع، لفكّ الارتباط الفلسطيني الرسمي مع مرحلة تونس. وتلخيصاً للدور التونسي في إيصال الفلسطينيين لحلمهم في تأسيس دولتهم، كما كشفت ذلك شهادات الفاعلين التونسيين في تلك المرحلة، على غرار القيادي الأمني النوري بوشعالة في مذكّراته “قبس من الذاكرة”. كتَب درويش، قصيدته للتونسيين عامة، نيابة عن الفلسطينيين عامة. لتتلقفها السلطة بالأساس شعاراً للمرحلة، الفلسطينيون اختاروها لتنقش على رخام أضرحة شهداء المجرزة الإسرائيلية في مدينة حمّام الشط سنة 1985. أما تونسياً، أمست جزءاً من بروباغندا نظام بن علي في مساندة القضية الفلسطينية.
وبرغم المرارة أمست القصيدة رسالة أمل، بثّها في نهايتها “سنلتقي غداً على أرض أختك فلسطين”. لم تحقق أوسلو النبوءة كاملة، أو ربما فرض مسار الأحداث المأساوي الأخير، مراجعة كلّية لشروط تحققها، بل ربما مسار أوسلو جملة واحدة، كما تشكك حوله درويش منذ البداية. ولكن القصيدة مع ذلك، عادت في زخم هذه الأحداث، لتكون شعار موجة تضامن جماهيري صادق هذه المرة. من قافلة الصمود الشعبية التي انطلقت من تونس في محاولة لكسر الحصار، وصولاً للنوّاب اليساريين الخارجين عن السرب مثل ديلوغو، الذي استغل زيارته للانضمام لجماهير الناشطين المتظاهرين في تونس أمام السفارة الأميركية، من أجل رفع الحصار، قبل أن يتحول نحو مبنى السفارة الفلسطينية وينشر صورة للقصيدة المنقوشة على الرخام بألوان بهتت مع الأيام. لولا مأساوية الأحداث، التي أعادتها للواجهة من جديد.