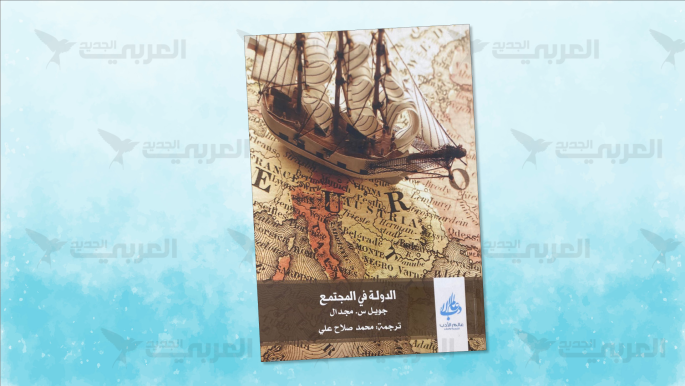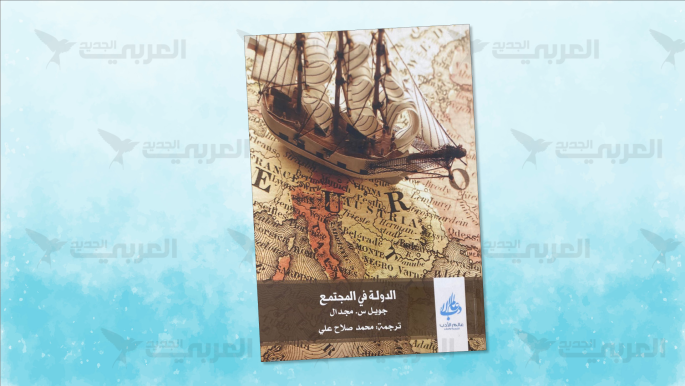
by | Sep 9, 2025 | أخبار العالم
يمثّل كتاب جويل مجدال “الدولة في المجتمع: دراسة كيف تحول الدولة والمجتمعات وتشكل بعضها بعضاً” (ترجمة محمد صلاح علي، عالم الآدب للبرمجيات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2017) محاولة جذرية لإعادة التفكير في مفهوم الدولة ومكانتها داخل الدراسات المقارنة للسياسة.
لم يكن الكتاب مجرّد إضافة للنقاش النظري، بل شكّل تحوّلاً نوعيّاً في طريقة النظر إلى الدولة: كيف نفهمها، وكيف ندرس تفاعلها مع المجتمع؟ على خلاف التعريف الكلاسيكي لماكس فيبر، الذي رأى الدولة الكيان الذي يحتكر العنف المشروع داخل الإقليم، قدّم مجدال رؤية أكثر تعقيداً: الدولة ليست مجرّد هيكل أو مؤسّسة، بل هي حقل متشابك من الصور والمآذارات. تمثل الصور ما تنتجه الدولة عن نفسها: الأعلام، الشعارات، الدساتير، والخطابات الرسمية التي تعكس سيادتها المزعومة. أما المآذارات فهي قدرة الدولة على جعل الناس يتبعون قواعدها في حياتهم اليومية. يوضح هذا التمييز الفجوة بين ما تدّعيه الدولة وما تنجح فعليّاً في فرضه، ويكشف أن الدولة ليست قوة مطلقة، بل هي طرفٌ في شبكة معقدة من الصراعات الاجتماعية والسياسية، متأثّراً بهذا التعريف بعالمي الاجتماع الفرنسيين؛ ميشيل فوكو في تأطيره مفهوم الصورة وبيير بورديو في تأطيره مفهوم الحقل في العلوم الاجتماعية.
لم تتشكّل هذه الرؤية في فراغ؛ فقد تشكّل وعي مجدال أولاً من خلال مقاربة إدوارد شيلز عن “المركز والمحيط”، التي تصوّر الدولة كمركز يمتلك القوة الرمزية والقانونية لإخضاع المجتمع التقليدي. اعتمد مجدال هذا التصور في بداياته، إلا أن هزيمة عام 1967 أظهرت له محدوديته، فإسرائيل، رغم قوتها العسكرية والبيروقراطية، لم تنجح في إخضاع المجتمع الفلسطيني أو فرض هيمنتها المطلقة، ما دفعه إلى إعادة النظر في نموذج المركز– المحيط (المقاربة المنهجية التي طوّرها إدوارد ميشلز وكان مجدال يتبنّاها)، والبحث عن فهم أكثر دقة لصراع الدولة مع القوى الاجتماعية على الشرعية والهيمنة.
ليست الدولة قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها
كما تأثر مجدال، في بداياته، بصموئيل هنتنغتون، خصوصاً خلال دراسته العليا في السياسة المقارنة، ونظرياته حول المؤسّسات السياسية واستقرار الأنظمة. ركّز هنتنغتون على دور المؤسسات في ضبط الصراعات وتحقيق استقرار الدولة، وهو ما بدا مقنعاً لمجدال في البداية. لكنه سرعان ما اكتشف أن التركيز على المؤسّسات وحدها يغفل الصراعات المجتمعية الفعلية والتفاعلات بين الدولة والقوى الاجتماعية، وهو ما دفعه لاحقاً إلى نقد محدودية هذا الطرح وتطوير رؤيته الخاصة، التي تراعي الدولة بوصفها شبكة متشابكة من الصور والمآذارات تتنافس مع قوى متعدّدة في المجتمع.
في هذا الإطار، جاء مجدال رد فعل مباشراً على جدل واسع في السياسة المقارنة، فالمرحلة السلوكية، بقيادة ديفيد إيستون وغابرييل ألموند، ألغت الدولة من التحليل، وركزت على “النظام السياسي” كآلة تحلل المدخلات والمخرجات دون النظر إلى خصوصية الدولة أو تاريخها المؤسّسي. ومع نهاية السبعينيات، جاءت موجة “استعادة الدولة” Bringing the State Back In، لتعيد الدولة إلى صدارة التحليل فاعلاً قادراً على فرض إرادته على المجتمع. في هذا السياق، ظهرت مقاربة الكوربوراتية، التي تصوّر الدولة منظّماً للمجتمع عبر قنوات رسمية شبه مؤسّساتية، مثل النقابات والجمعيات المهنية، فيما أشار غييرمو أودونيل إلى “البيروقراطية السلطوية” في أميركا اللاتينية، حيث الدولة العسكرية – البيروقراطية تفرض هيمنتها من أعلى، مطبّقة نظم السيطرة على المجتمع.
اشتبك مجدال مع كلا النموذجين (السلوكي وما بعد السلوكي)؛ فهو لم يكتفِ بالرفض السلوكي الذي ألغى الدولة، ولم يقتنع بالتصوّر المطلق لما بعد السلوكية والكوربوراتية. بل رأى أن الدولة ليست قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها. وهكذا صاغ جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف.
يستدعي هذا التحليل، أيضاً، أفكار غرامشي، إذ يوضح أن الهيمنة لا تقوم على القوة المادية وحدها، بل على القدرة على إنتاج منظومة قيمية تجعل السلطة مقبولة. الدولة تسعى إلى فرض هيمنتها عبر التعليم، القانون، الإعلام والمؤسّسات الرمزية، بينما تسعى الجماعات الاجتماعية إلى إنتاج هيمنتها الخاصة عبر الدين، العائلة، الشبكات التقليدية أو الاقتصاد غير الرسمي. بذلك يصبح الصراع على الشرعية والمعنى جزءًا من الصراع على القوة، ويظل فهم الدولة مستحيلاً بمعزل عن المجتمع.
الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي
يكتسب تحليل مجدال أبعاداً أعمق عند مقارنته بفكر محمد عابد الجابري لا سيما كما طرحه في كتابه “العقل السياسي العربي”، فالجابري أبرز أن العقل السياسي العربي يتأثر باللاشعور السياسي والمخيال الاجتماعي، بحيث يستحضر التاريخ في الحاضر ويعيد إنتاج أنماط الهيمنة والصراع القديمة، ويظهر أن الدولة العربية ليست مجرّد مؤسّسة قائمة بذاتها، بل محصلة لتفاعلات القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك يتقاطع بدقة مع مجدال، الذي أشار إلى الفجوة بين الصورة والمآذارات، أي ما تدّعيه الدولة من سيادة وما تستطيع فعليّاً فرضه على المجتمع. ومن هذا المنطلق، تمنحنا مقاربة مجدال أدوات لفهم هشاشة الدولة العربية، حيث تتنافس الجماعات المختلفة على فرض قواعدها وضبط القيم والمعايير الاجتماعية، وتظلّ الشرعية متعدّدة وغير مستقرّة.
حين نطبق هذا على الواقع العربي، يظهر مدى أهمية مقاربة مجدال. ففي العراق، تتنازع الدولة والمليشيات الطائفية على الولاءات والقواعد. في لبنان، تآذار الطوائف والأحزاب سلطة موازية، بينما تحوّلت الجماعات المسلحة في اليمن وليبيا إلى بديل حقيقي للدولة، ففي هذه الحالات، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها العسكرية أو الأمنية فقط، بل بقدرتها على جعل قواعدها المرجعية هي التي يلتزم بها الناس طوعاً.
لا تقتصر أهمية هذا التحليل على الجنوب فقط. ففي الغرب، تكشف تحوّلات القرن الحادي والعشرين عن محدودية الدولة: صعود الشعبوية، تراجع الثقة بالمؤسّسات، قوة الشركات الرقمية العملاقة، والحركات الاجتماعية العابرة للحدود. ويعكس ذلك كله أن “المآذارات” لم تعد حكراً على الدولة، حتى لو بقيت “الصورة” قوية.
صاغ مجدال جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف
تزداد أهمية هذه المقاربة عند النظر إلى أزمة شرعية الدولة في العالم العربي، فالدول الأوروبية استطاعت، عبر مفهوم الدولة – الأمة، أن تؤسّس لعقد اجتماعي نسقي متكامل يجمع بين الشرعية القانونية والسياسية والثقافية. في المقابل، تظل الدولة العربية في حالاتٍ كثيرة رهينة مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي، حيث لا تتأسّس الشرعية على إجماع شعبي مستقر، بل على سلطة تاريخية وبنى مادية، وغياب الوعي السياسي المدني، كما يشير محمد عابد الجابري. ومن هذا المنظور، يقدّم مجدال أدوات حيوية لفهم هذه الهشاشة، بإبراز أن الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي، وتتقاطع الصورة مع المآذارة لتنتج شرعيات متعدّدة وغير مستقرة.
في المحصلة، يقدّم مجدال حلقة ثالثة في تطوّر السياسة المقارنة: بعد تغييب الدولة سلوكيّاً، واستعادتها مطلقة في ما بعد السلوكية والكوربوراتية، جاء ليعيد الدولة والمجتمع معاً إلى قلب التحليل، فضاءً واحداً للصراع على الشرعية والهيمنة. ومن هنا يكتسب كتابه “الدولة في المجتمع” قيمته المرجعية، ليس فقط لفهم هشاشة الدولة العربية، بل أيضاً لتفسير التحولات الحديثة في العالم، من خلال إدراك الدولة والمجتمع كشبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، لا ككيان واحد منفصل أو متفوق دوماً.
يمثل كتاب “الدولة في المجتمع…” رؤية ديناميكية تمكّن الباحث من فهم تعقيدات الدولتين، العربية والغربية على حد سواء، وتقديم تحليل قادر على استيعاب هشاشة الدولة، صراعها مع المجتمع، وتعدّد فاعليتها، بعيداً عن النظريات الأحادية التي إما ألغت الدولة أو بالغت في هيمنتها، ليصبح مجدال مرجعاً ضروريّاً لكل دراسة مقارنة تبحث عن فهم معمّق للدولة والمجتمع في عالم معقّد ومتغير.

by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
لم يكن محمد عابد الجابري على صواب تام عندما كتب في 1973 عن التعريب في المغرب، ولم تكن القضية الأمازيغية بعدُ قد اكتست أي اعتبار مفهومي حتى بالنسبة إلى مثقفيها الرواد الذين التفوا حول جمعية التبادل الثقافي (1967). ولذلك طالب، في إطار مشروع تعليمي متكامل يقترحه لمغرب التحوّل الديمقراطي، بوجوب “إماتة” الفرنسية، ولو أنها لغة حضارة وثقافة، والأمازيغية معها (ثلاث لهجات أو دوارج محلية) والعربية الدارجة نفسها التي يتكلم بها عامة الناس. أما الاعتبارات التي قلّلت، كما أرى، من صواب الرأي، رغم أنه كان ذا نفحة تقدّمية قومية، فكامنة في أنه لم يصمُد طويلاً في وجه التطور التاريخي الذي تطوّرت فيه تلك “اللهجات”، وانتهى إليه منظور التعريب نفسه.
أول ما يلاحظ، بصورة عامة، أن المطالبة بالتعريب في مدى 50 سنة تقريباً، وفي بُعدٍ من المطالبة التشديد على اللغة العربية أساساً لِسْني وَعَقَدِي (لغة القرآن)، أصبحت، بصورة تدريجية، غريبة لم تعد تُرفع في أي برنامج إصلاحي ولا يسمع صوتها تقريباً، فلم تتمسّك بالتعريب، بصورة منظمة وإيديولوجية تعبوية تنهل من القومية والدين، إلا فئات حزبية تقليدية محدودة من المدافعين الخُلّص عن “الهوية العربية الإسلامية” المُنْدَمجة، الذين استوحوا “السلفية الجديدة” كما قعّدها علال الفاسي نظرياً وسياسياً، وجعلوها رافداً وطنياً، على نحو ما كانت عليه في أواسط القرن العشرين، لمقاومة الحماية والبعث الإسلامي وإحياء اللغة العربية والمطالبة بالاستقلال، ولو بعد فترة، في الوقت نفسه. إلا أن تلك الفئات التقليدية سرعان ما تصالحت مع الوضع القائم على إثر الفشل الذي مُنيت به في تحقيق الإصلاح ومقاومة الاستبداد المطلق، فاندمجت تلقائياً في الاختيار الفرانكفوني العام بالصيغة البراغماتية التي أوْجَبَها الوضع السياسي المتحوّل في البلاد على إثر تدشين ما سمي “المسلسل الديمقراطي” (1975)، وعودة الحياة النيابية نسبياً، بعد انقطاعٍ سنوات، إلى “المجال الشرعي” الرسمي الذي يرعاه النظام السياسي ويتحكم في اختياراته.
المطالبة بالتعريب في مدى 50 سنة تقريباً، أصبحت، بصورة تدريجية، غريبة لم تعد تُرفع في أي برنامج إصلاحي
من أقوى التعبيرات المجسّدة للتخلي عن المطالبة بالتعريب، بالمعنى الذي قاله الجابري، أن التعليم في المغرب أصبح، منذ 1965، حقل تجارب لكثير من السياسات المتناقضة والتنظيمات المستنسخة التي أغرقته في ما يمكن نعته بـ”الإصلاح المستحيل”، الذي كان يُراد به الإفساد المؤكّد والتخلي المدروس عن الاختيارات الوطنية الإصلاحية، وخصوصاً عندما حوّلته هذه الاختيارات، في مراحل كثيرة من تقاطب الصراع بين السلطة والمعارضة، إلى ساحةٍ تُقَادُ فيها المظاهرات الطلابية والنقابية والسياسية، وتُطْرَحُ فيها، بالشعارات الراديكالية المناسبة أحياناً، أقوى المطالب التي تؤجّج الوضع السياسي نفسه، كذلك تثير لدى الفئات الاجتماعية المتضررة من الهيمنة اللغوية الفرنسية شعوراً عاماً بالسيطرة الأجنبية وبطبيعة الاستغلال الذي تآذاره هذه السيطرة، وهي فرنسية بالأساس، على الصعيد الاقتصادي.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى المطالبة بالتعريب بوصفه برنامجاً لغوياً أيضاً، ذا منزع تحريري، للتخلص من الهيمنة التي كانت للحماية الفرنسية على مقاليد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، وهي التي أيضاً طبعت المسار العام للتاريخ المغربي الحديث في علاقة بالغرب من زاوية المثاقفة والإنتاج الثقافي والفكري والتأثير اللغوي الشامل. كذلك يمكن النظر أيضاً إلى فشل المطالبة بالتعريب بوصفه انقلاباً على الأماني التي عبرت عنها “الحركة الوطنية” منذ بداية نشاطها السياسي في الثلاثينيات ضمن الانقلاب الشامل الذي أطبَقَ وطبَّقَتْه “حالة الاستثناء” في البلاد، وكان من نتائجه أنه رَكَّز السلطة المستبدة المطلقة ونَظَّم، بصورة جوهرية، تلك الاختيارات الاقتصادية والسياسية، والثقافية كذلك، التي سعت، في إطار ما سمي اقتصادياً “المغربة” (1974)، للاستحواذ الشامل، بطريقة مختلفة، بحكم الانقلابات العامة التي تحققت للنظام الدولي في إطار العولمة الشاملة، على مختلف المَقْدُورات ذات الطبيعة المستقلة التي تطوّرت في البلاد في خضم النضال الشعبي ضد الهيمنة الرسمية المطلقة وسطوتها الاستبدادية.
إن مقاومة التعريب، لأنه كان مرفوعاً في وجه الفرنسة الشاملة، أضحت رديفاً إيديولوجياً وسياسياً فعليا للحط من قيمة اللغة العربية
يمكن القول، في هذا الإطار، إن مقاومة التعريب، لأنه كان مرفوعاً في وجه الفرنسة الشاملة، أضحت رديفاً إيديولوجياً وسياسياً فعليا للحط من قيمة اللغة العربية (صارت تُدْعَى كلاسيكية، رغم التنصيص عليها في الدستور منذ 1962)، فتقلص دورها في التواصل، وأمست الكتابة بها، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية لكتابها، مدعاةً للاحتقار والانتقاص المحمول على نرجسيّة تتغنى بالفرنسة والتجديد والعصرية والمثاقفة وما شابه. وهذا كله في محيطٍ تتعاظم فيه باستمرار ثلاثة مواقف متصادمة: واحد يعتبرها متجاوزة بسبب الجمود الذي خيّم عليها نتيجة لتخلفها عن مسايرة التطور التقني والعلمي والتكنولوجي الذي أصبح الصيغة المثلى، بما في ذلك على مستوى الشعار، للتطور وللنمو بغية تحقيق الازدهار والرقي واللحاق بالأمم السائرة في طريق النمو. والثاني بسبب السيطرة المطلقة للغة الفرنسية في مختلف مجالات الحياة والمعاملات وفي الإدارة العامة والخاصة للمؤسسات وللوزارات وعلى الصعيد الدبلوماسي إلخ، بوصفها لغة التداول والمراسلة والتخاطب والصفقات التجارية وغير التجارية والمخابرات، وهي في الآن نفسه، من خلال الشعور بالأهمية والقيمة الرمزية اللصيقة بالنموذج البرّاق المؤثر، لغة المستعمر القديم (وفي ثوبه الجديد) باني مقومات المغرب (الحديث) على أسس رأسمالية تبعية، وهي أيضاً لغة النخب المغربية الرسمية والوطنية التي أهلتها، في سياق التطور العام وبناءً على جدوى المصالح الفئوية الخاصة، لاحتلال مختلف المواقع الاقتصادية والتجارية والإدارية وفي تسيير شؤون الدولة والسيطرة والتحكم والاستغلال بشكل عام. والثالث في نتيجة منطقية لطبيعة اللغة نفسها من حيث التركيب والنحو والصرف، أي لغة مكتوبة ذات طبيعة عالمة في كل ما تنتجه من حيث الكفاية، مقارنة لها بغيرها في سوق اللغات، والأجنبية منها بخاصة، التي لها، على الصعيد المحلي، مواقع اقتصادية وثقافية تاريخية بارزة ومهمة ترشحها، على قاعدة تنافسية في علاقة بالعلوم والتطور العام، للقيام بالأدوار المطلوبة في نطاق العولمة الشاملة التي ترهن المجالات المتصلة كافة، أو المرتبطة، بها بالمصالح الكبرى التي تتوخاها من السيطرة الاقتصادية والتجارية الشاملة على الصعيد العالمي.
أما الأمازيغية التي اعتبرها محمد عابد الجابري قبل 50 سنة “لهجة”، وهي ثلاث (تَرِيفِيتْ، تمَازيغت، تَشِلْحِيت) يتكلّم بها قسم كبير من المغاربة في ثلاث مناطق جغرافية متباعدة نسبياً، وتتميز، باعتبارها “لهجة” في حد ذاتها، بالاختلاف النسبي في مفرداتها وقواعدها الصوتية والنحوية (رغم انتمائها إلى عائلة لغوية واحدة) فقد انتقلت، بفعل النضالات المدنية التي خاضها النشطاء الأمازيغيون، على اختلاف توجهاتهم وجمعياتهم طوال عقود، من المطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية، بناءً على التصوّر الهوياتي المختلف (عن العروبة والعربية والقومية العربية)، إلى تكوين رأي عام لعبت فيه بعض الأحزاب التقدمية دوراً مهماً في التطورات اللاحقة التي بَلْوَرَت حولها ما يمكن وصفه بـ”الذهنية الأمازيغية” التي ازدهرت فيها، وفي بعض جوانب هذا الازدهار ملامح ثقافية ذات أبعاد عنصرية ترافقت مع عشرية الأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية، شعارات ثقافية وسياسية وتاريخية متنوعة، ربما كان الهدف منها العمل على استكمال جوانب من “الهوية الإثنية” المبنيّة على أسس ثقافية واجتماعية تتقاطع مع الجغرافيا والدين، إلخ، وهي الراسخة في التراب المغربي منذ حقب بعيدة، ولعلها طُمست منذ القدم بسبب عوامل مختلفة.
جاء دستور 2011 في حمى هبّاتِ “الربيع العربي”، فَحَوَّل الأمازيغية إلى لغة رسمية معبّرة عن هوية مختلفة قوامها اللغة (تيفيناغ) والثقافة (تاريخ تَمَازْغَا)
جاء دستور 2011 في حمى هبّاتِ “الربيع العربي”، فَحَوَّل الأمازيغية، بعد تقاربات وإشارات اندرجت في السياسة العامة من حيث يسَّرت انتقال الملك، بناءً على “البَيْعَة”، إلى لغة رسمية معبّرة عن هوية مختلفة قوامها اللغة (تيفيناغ) والثقافة (تاريخ تَمَازْغَا)، لها ما يتطلبه البحث في سبيل نشرها وتعميمها رسمياً، متوجة بذلك مسيراً معقداً احتَشَدَت فيه مبرّرات شتى رُوعِيت فيها “طبيعة” التجربة المغربية في التغلب على المشكلات العويصة التي يبلورها التطوّر، أو يفرضها النضال، أي من خلال المساومة والتسليم بالأمر الواقع الذي يعني، في جوانب منه، الإقرار بحقائق الاختلاف بغية صوغ الاندماج (يمكن تأويله استدماجاً من الناحية النفسية أو أسلوب تدجين بالمنطق السياسي). أما العربية الدارجة، فقد تحوّلت، وأساساً من خلال اعتماد المصطلح اللساني المغشوش الذي يضفي “المعيارية” على العربية (Standardisation)، إلى “لغة” شاملة أقيمت حولها مناظرات، وأنجزت بها بعض الأطاريح، وظهر بها مبدعون في ساحة الأدب (الشعبي) من خلال الزجل (الشعر العامي) والقصة والحكاية وسواها، وربما كان الأهم من ذلك كله أنْ صدر حولها مُعْجَمٌ حديث، جَرْياً على العادة التي اتبعها بعض الفرنسيين العاملين في جهاز الحماية في التأليف لغير الناطقين بها، يسهل اعتمادها في فنون وأغراض مختلفة.
النتيجة النهائية لهذه التحولات أن المغرب على مستوى التعدّد اللساني أصبح أمام حقيقة كبرى: كيف يمكن صناعة “الوحدة الوطنية” والمذهبية التي يتغنّى بها الطامحون لبناء المجتمع الديمقراطي ودولة المؤسّسات اعتماداً على هويات متصادمة لها اختيارات متناقضة وخطابات تنبني على لغات مختلفة؟ بعبارة أخرى، ولو أنها إشكالية قديمة: بالديمقراطية الرشيدة عبر الإقرار بالتنوع والاختلاف في تساوق مع بناء دولة المؤسسات، أم بالاستبداد الذي يفرض التحكم والدَّمْج، حسب الظروف وطبائع الأمور، وليس له من أداة فعلية إلا القمع وفيه المصادرة؟

by | Sep 3, 2025 | أخبار العالم
يفيد المشهد السوري الراهن بأن العصبيّات هي العدو الأساسي الذي يعاني منه مفهوم الفضاء العمومي السوري، ومن ثم، بطبيعة الحال، مفهومات الوطنية، والدولة، والسياسة، امتداداً إلى التنمية، والعدالة، وكرامة الإنسان، وحقوقه. وللأسف، تتورّط السلطة الانتقالية في لعبة العصبيات هذه أيضاً. تعمل العصبيات في سورية بوصفها “عدواناً” بوساطة تحويل الانتماء السياسي إلى رابطة عاطفية، تستمد قوتها من الدين والطائفة والإثنية. وبهذا المعنى هي تعمل بوصفها امتداداً للعصبية الصناعية التي بناها حافظ الأسد على مستوى أسلوب التفكير، فلو نظرنا إلى النقاشات العامة بشأن ما يحدُث في السويداء، مثلاً، لشاهدنا بوضوح أنّها لا تخرُج في مجملها عن أسلوب تفكير العصبيّات. وفي هذه الحالة الفاقعة، يبدو اللاوعي الثقافي والاجتماعي سيّد المشهد، ويلعب دوراً أشبه باللاوعي عند الفرد كما حدَّده فرويد؛ من ثم يصير الوعي الذي يحيل على استخدام العقل والمنطق، محكوماً بالعبارة الشهيرة في عصور الانحطاط الإسلامي: “من تمنطق تزندق”، وهذا ليس مجازاً، فالكلام الذي ينتج من سلسلة تفكير منطقية تستهدف المستقبل، وتسعى إلى صوْن الدماء والكرامات والحرّيات، صار يجلب لصاحبه الشتائم، والتخوين، والاتهامات المتناقضة من أطراف الصراع؛ فكلٌ يبني التهمة حسب موجبات الوجهة العصبيَّة لجماعته، ويستخدم هذه التهمة لمواجهة أسلوب التفكير الجدلي الموضوعي الذي يرى ما للبشر وما عليهم.
بما أن العصبيّات عدوان، فهذا يعني أن السوريين يحتاجون عملية ثانية لردع العدوان، غير أنها هذه المرّة لا تتم بوساطة الجرأة على استخدام السلاح؛ بل الجرأة على حل المشكلات من دون السلاح، أو بتعبير كانط: الجرأة على الاستخدام العمومي للعقل. وإذا كانت عملية ردع العدوان قد طردت إيران الخمينية من سورية، فإن العملية الثانية ينبغي أن تطرد “إيران الساسانية” من رؤوس السوريين، وأنماط مقارباتهم للسياسة، أي أن تطرد فكرة الدولة السلطانية التي نعيش في ظلها منذ صار الحاكم الإسلامي “ظل الله في الأرض”، بتأثرٍ واضح بطريقة كسرى في الحكم، أو منذ وُلد “الإسلام الكسروي” بتعبيرات محمد عابد الجابري. وطرد فكرة “الدولة السلطانية” من العقول السياسية يُعدُّ أيضاً شرطاً للتحرير، وردعاً للعدوان.
ليست العصبيات عدواناً فحسب، بل إنها تحتضن بيئة صناعة العدو بوصفه ضرورةً حيوية للعصبية، فمن دون العدو تتراخى النعرة، ولا تحقّق العصبية الحالة العامة الضرورية لوجودها، وهي حالة الـ”نحن” المساوية لمجتمع الفضائل، مقابل حالة الـ”هم” المساوية لمجتمع الرذائل والشرور. ومن ثم، تعني هذا القدرة على الاستخدام العمومي للعقل، ومجابهة العصبيات أيّاً كانت، تعني النجاة من الـ”نا” الدالة على الجماعة العصبية، من ثم أن يتحوَّل الناجون إلى فاعلين، فالمستقبل في سورية يبدأ من نتيجة فعلهم، ومن دونهم يستمر هذا البلد في طريقه إلى الماضي، والتأخر تاريخيًا أكثر مما هو متأخّر أساساً.
إن كان لبنان هو البلد الأول في العالم الذي يمتلك دستوراً وميثاقاً، فإن سورية، على ما يبدو، تمشي في طريقها إلى احتلال المركز الثاني في العالم
إذا تمعنّا، بموجب هذه المقاربة، في المشكلة في السويداء، أو في الساحل، أو في الجزيرة السورية، نجد أن الخصوم يختلفون في موضوع التفكير، وفي طريقة تحديد مشكلاتهم، غير أنهم يشتركون في أسلوب التفكير العصبوي بهذه المشكلات، اشتراكاً واضحاً يجعل الحلَّ مسألة صعبةً للغاية. ولهذا الأسلوب خصائص حدّدها باقتدارٍ مصطفى حجازي في حديثه عن العصبيات وآفاتها في سياق هدر المشروع الوطني، وهي: أولاً، اليقين القطعي الذي يفيد بأن العصبية الوحيدة التي تمتلك الحقيقة، وزعيمها مثالي لا يرتكب الأخطاء، وأعضاؤها نسخةٌ بعضهم من بعض، وصولاً إلى أن يصيروا هم العصبية والعصبية هم، فقبل أن يقتلوا الآخر يكونون قد أجهزوا على مفهوم الفرد، ومَثَّلوا بجثته. ثانياً: التعميم، وهذه نراها في عباراتٍ صارت رائجة جداً تكثفها عبارة “كلهم ضدّنا”، فيصير “كلُّ الدروز عملاء لإسرائيل”، و”كلُّ السنة متواطئون في قتل الدروز”، وإلى آخر هذا النوع من التعميمات. ثالثاً: الأحكام المُسبقة، التي تؤدّي إلى غزو الفضاء العام بالوهم فيصير من السهل القول بوجود “موقف درزي”، و”العلويون قتلوا السوريين”، و”السنّة يشعرون بالخوف من عودة الأقليات إلى الحكم”، إلى ما هنالك. ورابعاً: إلغاء التفكير الجدلي؛ فتتكون ثنائيات حادّة، معي أو ضدّي؛ فإما أن يقبل المرء بانفصال السويداء، أو يتم اتهامه بأنه مع المجزرة! وقد تتطوّر التهمة إلى السلفية الجهادية والتخوين، كما كان حافظ الأسد يتّهم مسيحيين بالانتماء للإخوان المسلمين! خامساً، والأكثر أهمية هي “الأزليَّة”، وهذه أيضاً استخدمتها عصبية الأسد عندما كانت تقول بخلود الرسالة، ولا نزال نراها بصورٍ مختلفة؛ فهذا شيخٌ درزي يريد إقليماً منفصلاً إلى “أبد الآبدين” (بتعبيراته)، وآخرون يكررون مع وزير الثقافة أن “دمشق لنا إلى يوم القيامة”؛ وكأن هذه الـ”نا” تدل على جماعةٍ طبيعية ناجزة، ولا تحتاج إلى ابتكارٍ وهندسة سياسية وإنسانية. ولنفكِّر قليلاً بهذا التشابه الكارثي بين العبارات الثلاث: “الرسالة الخالدة”، و”إلى أبد الآبدين”، و”إلى يوم القيامة”، ولنسأل أنفسنا ما الذي تغير في أسلوب التفكير؟ وفي ظل هذا الأسلوب الذي تمثله النقاط الخمس السابقة، ألا يصبح مفهوم المواطنة، والسعي إلى المواطنة، مجرّد إشاعة؟ فيما الواقع يشبه كلام شيخ الدين الدرزي نفسه عندما قال إنه يناشد كلاً من “سيده سلمان”، والعالم الحر من أجل إقليمٍ منفصل، وأن الذي يعمل ضد الانفصال من أبناء طائفته قد باع ضميره، وينبغي أن “يكفي الجماعة شرَّه”، كما قال.
وعلى سيرة الضمير، لنفكِّر بوساطة العلم، وبالعقل، والمنطق، ونسأل: ما الذي يُعطِّل الضمير أكثر من فكرة الانتماء إلى الجمع الكبير الذي لا يفكِّر؟ وأكثر مِن الجمع الذي يستسلم للاوعي الفرويدي في سلوكه ومقارباته وطريقة كلامه، ويصنع الروابط العضوية فيه استناداً إلى الدين، والطائفة، والعائلة، والإثنية، وما إلى ذلك؟ ينطبق هذا الكلام على الجماعات العصبية المتنازعة في سورية كلها، وليس حكراً على جماعةٍ من دون غيرها؛ فلكلّ منها موضوعه، وأهدافه، ولكنَّهم يتشاركون أسلوب التفكير نفسه.
السوريون لا يتشاركون شيئاً كبيراً هذه الأيام مثلما يتشاركون نمط التفكير العصبوي
ولنفكِّر في مسألة أخرى، أن في سورية إعلاناً دستوريّاً، مقبولاً أو مرفوضاً، إلا أنه مُعلن، وبما أنه مُعلن فإن مُعلنيه في الحد الأدنى متفقون على صحته؛ ولكن مُعلنيه أنفسهم لجأوا معه إلى “الميثاقية”، المُتمثلة في اتفاقات صارت موجودة في الأدبيات السورية الراهنة، ويتم التعامل معها بشكلٍ طبيعي، مثل اتفاقات الحكومة مع حكمت الهجري، أو اتفاق قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مع الرئيس أحمد الشرع. هذا يُذكِّرنا بحالة لبنان، حيث ثمّة دستور للكل، ولكن هناك أيضاً ميثاقية يمثلها “اتفاق الطائف”، وفيها محاصصة وتطييف للحياة السياسية، بما يتعارض مع روح الدستور اللبناني الحديث، وبما يؤدّي إلى ضرباتٍ قاصمةٍ مستمرةٍ في مفهوم الدولة، وصولاً إلى هدرها، ومن ثم هدر الوطن. وإن صحّت الملاحظة أن لبنان هو البلد الأول في العالم الذي يمتلك دستوراً وميثاقاً، فإن سورية، على ما يبدو، تمشي في طريقها إلى احتلال المركز الثاني في العالم.
باختصارٍ وتكثيف، نحن في سورية الجديدة أمام شيءٍ نسميه “مُعاصبةً”، وليس مواطنة، فالألف في هذا النوع من الاشتقاقات اللغوية تُفيد المشاركة، والسوريون لا يتشاركون شيئاً كبيراً هذه الأيام مثلما يتشاركون نمط التفكير العصبوي. لذلك نحتاج عملية ردعٍ للعدوان، سياسيةٍ فكريةٍ، تُحوِّلنا من حالة “المُعاصِبين” الذين يتشاركون العصبية بالمعنى الذي طرحه ابن خلدون، إلى حالة المواطنين كما يعرفها العالم الحُر الكريم. وهذا يحتاج إدارة للعمليات الفكرية السياسية، لا العسكرية، تضع في مقدّمة أهدافها تدمير مفهوم الشوكة؛ وصولاً إلى رفض مقولة “قويت شوكتهم” أو “ضعفت”، و”ضعفت شوكتنا” أو “قويت”؛ بل إحالة مفهوم الشوكة الخلدوني هذا إلى التقاعد، والتفكير في ابتكار شرعيةٍ بنيوية. وأخيراً، يجد صاحب هذه السطور نفسه مضطرّاً لقول رأي أكثر صراحة كالآتي: القول إن “دستورنا التوحيد” كما قال الهجري في السويداء هو كارثة، توازي كارثة شدّ عصب “السُنة”، وتحويلهم إلى طائفةٍ في رحلة البحث عن الشرعية السياسية و”الشوكة” الخلدونية؛ فإذا كانت الأولى قد تؤدي إلى القضاء على السويداء، فقد تؤدّي الثانية إلى القضاء على سورية، لأن “السُنة” في سورية هي الجماعة التي تحمل المشروع الوطني تاريخيّاً. الأقلية الناجية من الانتماء العصبي هي حاضنة مشروع التفكير هذا، وهي سندُ من لا يزالون أفراداً قادرين على مآذارة فعل التفكير السياسي، والانتماء إلى الوطن من بوابة الوعي والضمير.