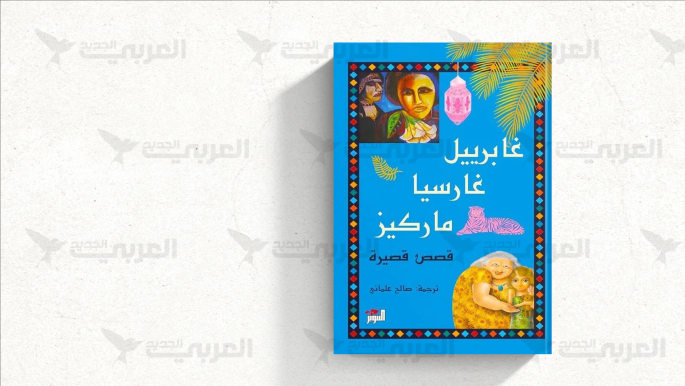
غابو وأشباح الساعة السادسة
رغم مرور أحد عشر عاماً على رحيله، ما زال غابرييل غارسيا ماركيز متجدداً، وقادراً على إدهاش قرائه، سواء بروايته “نلتقي في آب” (رندم هاوس، 2024)، وترجمت إلى العربية بعنوان “موعدنا في شهر آب”، أو بأعماله القصصية الأربعة التي صدرت مجتمعة في كتاب واحد عن دار التنوير البيروتية مطلع هذا العام، بترجمة صالح علماني.
ويتيح الإصدار القصصي المتجدد لمحبي الروائي الكولومبي الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1982، أن يقرؤوا أعماله القصصية الكاملة متسلسلة زمنياً، ومتجاورة ورقياً، ومتدرجة فنياً، بعد أن كانوا قرؤوها مُنَجَّمة في أزمان متباعدة، من دون أن تُتيحَ لهم القراءة المتفرقة نظرة شاملة وفاحصة إلى مجمل التجربة القصصية لماركيز، الموازية لتجربته الروائية، ولا تقلّ عنها أهمية. وإذا صحَّ القول إنَّ “مئة عام من العزلة” (1967)، هي ذروة المنحنى في تجربته الروائية فإنَّ النضج الفني الذي بلغته مجموعة “اثنتا عشرة قصة مهاجرة” يضعها في مرتبة الجوهرة بين المجموعات القصصية التي أنجزها على امتداد ثلاثة عقود، بدءاً من خمسينيات القرن العشرين.
كانت الذكريات المزيفة مقنعة لدرجة أنها حلّت محلَّ الواقع
كثيراً ما ترد عبارة “أشباح الساعة السادسة” في أعمال ماركيز الروائية والقصصية، وفي كل موضع ترد فيه العبارة نجدها تشير إلى الوقت الذي يسبق غروب الشمس في بلدان البحر الكاريبي اللاتينية، ودائماً ما يُصور البطل في هذا الوقت وهو في أشدِّ حالات العزلة والوحشة، مضطجعاً في ناموسيته المعلّقة، أو جالساً على شرفة بيته، أو جائلاً في غرف البيت الخالية إلّا من الذكريات ووجوه الغائبين المعلقة على الجدران. وتتفاعل الحالة النفسية القاسية مع اللحظة الزمنية لتخلق مناخاً من التشوّش البصري والانفلات الذهني، وهو المناخ المناسب لانهيار حدود الذاكرة والعقل والبصر، بين ما هو منطقي وما هو لامنطقي، وبين ما هو تاريخي وما هو أسطوري، وبين ما هو حقيقي وما هو سوريالي.
“أشباح الساعة السادسة” أحد المفاتيح التي طوّرها ماركيز لفتح البوابات بين الواقعي والخيالي، وهو يعلم أنها عبارة غامضة، وقد تكون عديمة المعنى، لكنها ذات وقع حسي يبعث على الشك في الحواس الواعية، ويتيح لللاوعي تولّي القيادة، والسيطرة على مجريات الأحداث. فلا غرابة أن تحمل الأشباحُ العريقة الساكنة في قلعة جبلية منعزلة، في قصة “رعب في آب”، الكاتب وزوجته، النائمين في حجرة في الطابق الثاني من القلعة، ليستيقظا في حجرة أخرى في الطابق الثالث، ذلك لأن الأشباح لا تسكن في حجرات القلاع القديمة فحسب، إنما تسكن في حجرات اللاوعي لدى الشخصيات القصصية، خصوصاً الشغوفة بقصص الميتين.
خصَّ ماركيز مجموعة “اثنتا عشرة قصة مهاجرة” بتقدمة أوضح فيها ظروف كتابتها، والأطوار التي مرّتْ بها القصص، من ملاحظات ومقالات ومشاريع سيناريوهات سينمائية وحوادث واقعية، وصولاً إلى طور الاكتمال بعد ثمانية عشر عاماً من الهجر والعودة. يقول ماركيز في تقدمته للمجموعة: “بدت لي ذكرياتي الواقعية أوهاماً من الذاكرة، بينما كانت الذكريات المزيفة مقنعة لدرجة أنها حلّت محلَّ الواقع. ولم يكن عليَّ أنْ أسأل نفسي أين تنتهي الحياة، وأين يبدأ الخيال”. وبهذه الجرأة على التحرر من رقابة الحقيقة، استطاع أن يمضي بلعبة تزييف الذكريات إلى أبعد مدى في قصص المجموعة، ففي قصة “القِدّيسة”، يقلب المخرج السينمائي المفاهيم، فيصنِّف الناس إلى فريقين، مَن يصدقون قيامة طفلة ميتة وهم الواقعيون، والفريق الثاني مِن غير الواقعيين، كالماركسيين والماديين، وهم الذين لا يصدقون أنّ الطفلة التي دُفنت قبل عشر سنوات يمكن أن تنهض من موتها.
تقصّد أنْ يعالج الحزن والسذاجة والقسوة التي لا تحتمل
تخلّى ماركيز في هذه المجموعة عن دفتر اليوميّات، الذي يمثل السجل الحقيقي لأحداث القصص كما شهدها، أو سمعها من ألسنة المهاجرين الكاريبيين، مُدعياً أنَّ الدفتر ضاع، ولكن هل يمكن الوثوق برواية ساحر مثل “غابو” حين يقرر أنْ يحرر ذاكرته من قيود الأحداث الواقعية، وأنْ يُلقي عصاه في أرض الخيال، مطلقاً العنان لأشباح الساعة السادسة كي تفعل فعلها العجيب في الأحداث، معتمداً على حُجّة مقنعة سمّاها (المنظور الزمني)، ويعني بها ميزة الشك في حقيقية الأحداث التي يمنحها انقضاء الزمن. ويشبّه ماركيز الكتابة من منطلق المنظور الزمني “بالحالة الإنسانية الأقرب إلى الطفو في الهواء”، وبها تصبح الكتابة “سلسلة وممتعة، وقادرة على تجاوز انحرافات عدم اليقين”.
ثمة مسوّغ فني في كل قصة ماركيزية يأتلف فيها الحلم بالواقع، في هذه المجموعة، وفي المجموعات الثلاث السابقة ذات العوالم الواقعية الصلبة، والعمق الإنساني المؤثر. وبدون هذا المسوِّغ تكون القصة ضرباً من العجز عن الإقناع، والفقر في الخيال، والحشو العبثي. ففي “القصة العجيبة والحزينة لإرينديرا الساذجة وجدتها القاسية”، من مجموعته الثانية التي تحمل العنوان نفسه، يبرز مسوّغ آخر لمعالجة الحدث الرئيسي في القصة، يتمثل في المبالغة في وصف الحادثة القبيحة، بهدف أنْ تغدو المبالغة في تقبيح الواقع حيلة فنية للتخفيف من أثره، من غير مساس بجدية المأساة الإنسانية وواقعيتها. وفي عنوان القصة ثمة كلمة واحدة منتقاة بعناية لتعبّر عن هذه الحيلة الفنية، هي كلمة (العجيبة)، فقد تقصّد ماركيز أنْ يعالج الحزن والسذاجة والقسوة التي لا تحتمل، بأسلوب سردي عجائبي. فعلى أرض الواقع، لا تكون الجدة، التي تجبر حفيدتها ابنة الأربعة عشر عاماً على أن تكون بغيّاً، قاسية فحسب، بل سادية أيضاً. ولا تكون الحفيدة التي تقع فريسة للبغاء، ضحية حزينة للجدة فحسب، بل للمجتمع الذي يرتضي أنْ يدخل عليها آلاف الرجال في خيمتها من دون أن يبادر إلى إنقاذها من هذا الواقع القبيح. إلا أنّ ماركيز ما كان ليقدم للقارئ حادثة بهذه الفجاجة والشذوذ بحالتها الخام، لأنه أذكى من يكون كاتب محاضِر، أو موثق حوادث. ويعرف أن الواقع الفني ليس سِجلّاً للواقع الاجتماعي.
توصل ماركيز إلى الحيلة الفنية بتضخيم الحدث، والمبالغة في تصوير الشخصيات، فجعل من الحفيدة كائناً أثيرياً، وكلما زاد تلوث جسدها بالوحل، زادت روحها نقاء، وغفرت لجدتها قسوتها، وازدادت تعلقاً بها. أما الجدة فبدت كائنا خرافياً، مثل (طائر السيمرغ)، تلقي بحفيدتها في المحرقة وهي موقنة أن الحفيدة ستتحمل العذاب، كما تحملت هي في شبابها.
لا تنتمي قصص الكتاب الاثنتان والثلاثون إلى التيار العجائبي، بل إن معظمها ينتمي إلى النوع الواقعي الحسي، الذي يركز فيه ماركيز على تصوير المناخ الكاريبي الملتهب بالحرارة، أو الغارق بالمطر الغزير، أو المضمّخ بروائح النباتات النفّاذة.
* قاص من الأردن

