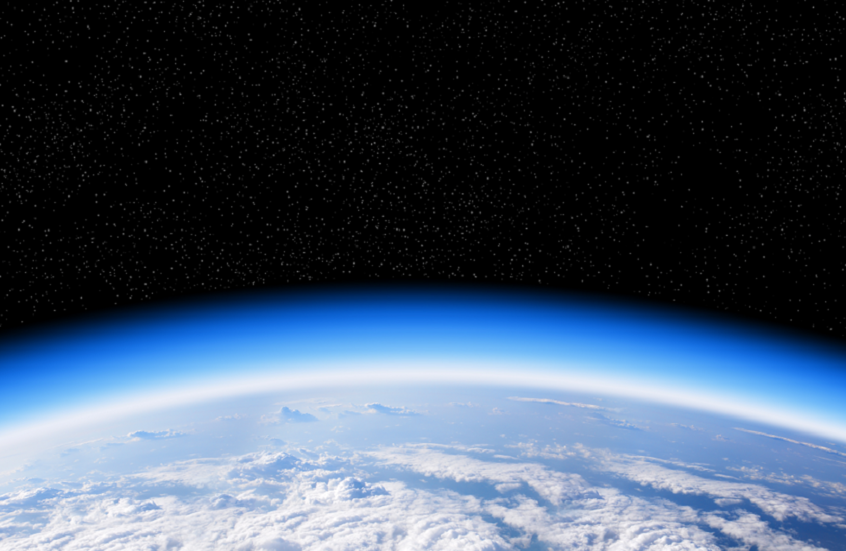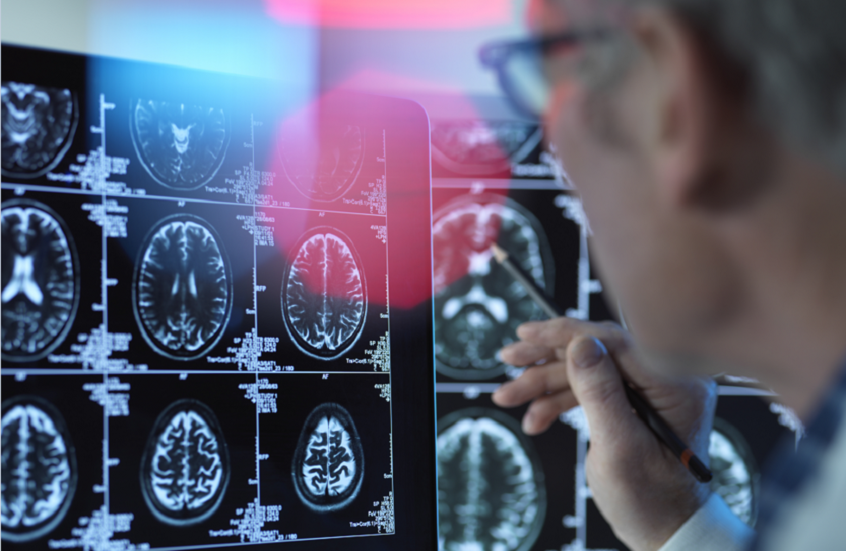
علماء يكتشفون مركبات طبيعية يمكن أن تحمي الدماغ من ألزهايمر
تمكن العلماء من تحديد مركبين طبيعيين يمكن أن يساعدا في عكس شيخوخة خلايا الدماغ وإزالة تراكم البروتينات الضارة، ما يبعث الأمل في إيجاد نهج غير دوائي لعلاج مرض ألزهايمر.
وكشفت الدراسة عن مركبين طبيعيين هما النيكوتيناميد (شكل من فيتامين B3) ومضاد الأكسدة الموجود في الشاي الأخضر المعروف باسم إبيغالوكاتيشين غالات (EGCG)، حيث يساعدان في استعادة جزيء رئيسي يغذي إنتاج الطاقة في خلايا الدماغ.
ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية المعالجة بهذه المركبات لم تشهد فقط عكس التدهور المرتبط بالعمر، بل أيضا تحسنا في القدرة على التخلص من تجمعات بروتين الأميلويد، وهي السمة المميزة لمرض ألزهايمر.
وقال غريغوري بروير، المؤلف الرئيسي للدراسة: “مع تقدم الناس في العمر، تظهر أدمغتهم انخفاضا في مستويات الطاقة العصبية، ما يحد من القدرة على إزالة البروتينات غير المرغوب فيها والمكونات التالفة”.
وأضاف الدكتور بروير: “وجدنا أن استعادة مستويات الطاقة تساعد الخلايا العصبية على استعادة وظيفة التنظيف الحرجة هذه”.
واستخدم الباحثون جزيئا فلورسنتيا (Fluorescent Molecule) لتتبع مستويات ثلاثي فوسفات الغوانوزين (GTP) الحية في الخلايا العصبية لفئران مسنة أظهرت علامات ألزهايمر. ووجد العلماء أن مستويات جزيئات ثلاثي فوسفات الغوانوزين الغنية بالطاقة انخفضت مع تقدم العمر، خاصة في الميتوكوندريا الخاصة بالخلايا، ما أدى إلى ضعف التخلص من الخلايا ذات المكونات التالفة في عملية تسمى الالتهام الذاتي.
وعلى الرغم أنه من المعروف أن الالتهام الذاتي (عملية التنظيف الطبيعية للخلية) يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة الأنسجة والأعضاء، إلا أن الجزء المسؤول عن التسبب في ضعف هذه العملية مع التقدم في العمر ما يزال غير معروف.
وعندما عولجت الخلايا العصبية المسنة لمدة 24 ساعة فقط بجزيئات النيكوتيناميد وإبيغالوكاتيشين غالات، تم استعادة مستويات ثلاثي فوسفات الغوانوزين إلى المستويات التي ترى عادة في الخلايا الأصغر سنا.
وكتب العلماء: “تكشف نتائجنا عن عجز طاقة ثلاثي فوسفات الغوانوزين العصبية المرتبط بالعمر ومرض ألزهايمر الذي يعيق الالتهام الذاتي”.
كما حسنت الجزيئات أيض الطاقة داخل هذه الخلايا، وكذلك التخلص الكفء من تجمعات أميلويد بيتا.
وقال الدكتور بروير: “من خلال دعم أنظمة الطاقة في الدماغ بمركبات متاحة بالفعل كمكملات غذائية، قد يكون لدينا مسار جديد لعلاج التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ومرض ألزهايمر”.
وأضاف: “تسلط هذه الدراسة الضوء على ثلاثي فوسفات الغوانوزين كمصدر للطاقة لم يحظ بالتقدير الكافي سابقا لدفع وظائف الدماغ الحيوية”.
وحذر الباحثون من الحاجة إلى المزيد من الدراسات لإيجاد أفضل طريقة لإعطاء هذه المركبات كعلاج.
المصدر: إندبندنت