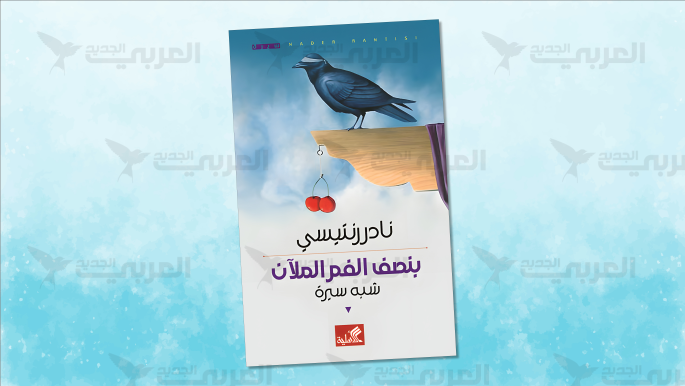by | Aug 29, 2025 | أخبار العالم
“ضخامة نيويورك الهائلة جعلتني ذرة تافهة” اعترف مرة إدوارد سعيد. أما بطلة رواية “إعصار عذب” للروائية السورية شادية الأتاسي فتشكو من أن “إيقاع المدينة البطيء يقتلني”. وتستغرب بكاء الناس في لوزان وسط الأمان والرفاهية، وهي القادمة من دمشق تحت النار. فيصبح الموت والدفن في المنفى معضلة.
ويتجلى الاغتراب في الرواية عبر لجوء بعض السوريين إلى رفض المجتمع الجديد ونعته بالفاجر، وتحذير الآخرين من الاندماج فيه. وفي تفسير عميق، للاغتراب يرى ميخائيل نعيمة أنه تيه الإنسان عن ذاته وعن عالمه الروحي، إذ يقول: “لا غربة إلا غربة الإنسان عن ربه ونفسه”. أما ماركس فقد رآه ظاهرة تاريخية ذات أصول اجتماعية واقتصادية تنتجها الرأسمالية ومجتمعها الاستهلاكي حيث يتم تشييء الإنسان.
في المقابل، عاش الإنسان المعاصر الاغتراب وهو في مكانه، مع اتجاه الحضارة إلى العولمة وتفتيت الهويات المحلية. بينما تتضاعف مشكلة إنسان العالم الثالث، مع اضطراره أحياناً للهجرة هرباً من الموت في بلدان تأكلها الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية، حاملاً ذاكرة الألم ومخاطر طريق اللجوء. ومع تغيير المكان والجغرافيا، ينشأ إحساس فقدان الجذور والاغتراب الثقافي وغربة اللغة التي تقف عائقاً أمام التواصل والاندماج.
في رواية “صيف سويسري” للروائية العراقية إنعام كجه جي، فيأخذ حاتم الحاتمي، أحد شخصيات العمل، وضعية الجنين قائلاً: “ما عادت آدميتي تستقيم إلا في الرقاد”. إنها رغبة لاشعورية في العودة إلى الرحم الأولى حيث الأمان هرباً من حالة الصراع إلى القوقعة الذاتية. وتطرح الرواية تجربة أجرتها شركة أدوية في بازل لتفكيك ما تسميه “الإدمان العقائدي” عبر أدوية تُعطى لعراقيين، فتحوّلهم إلى فئران تجارب في مدينة بازل، التي تُعد عاصمة الدواء عالمياً.
قد يمنح الاغتراب الإنسان قدرة على بناء هوية مركبة جديدة
والعينة التي اختارتها متناقضة الانتماءات والعقائد: فهناك الجلاد حاتم، ضابط المخابرات في نظام صدام البعثي، مع الضحية بشيرة، الشيوعية التي عُذبت واغتُصبت على يد المخابرات. وعلى المقلب الآخر هناك غزوان المتدين الشيعي المتمسك بأعراف الطائفة وتقاليدها، ودلاله الآشورية الداعية المبشّرة لشهود يهوه. أما الدكتور بلاسم، الذي اختير لإدارة الجلسات لِيُبلسم النفوس ويخرجها من كهوفها إلى النور، فيرى أنهم ليسوا إرهابيين، لكنهم “مدمنو أوهام” تدفعهم إلى عدم الاندماج.
يتمنى غزوان البابلي أن ينجح العلماء في تغيير شريط الذاكرة لينسى الخوف الذي في داخله. فهذا الخوف والتمزق، مع تفاقم الحالة الشعورية في التذكر وإعادة إنتاج الألم، قد يسبّب للشخص انهياراً تاماً. ولعل هذا ما جعل غزوان البابلي يتأثر سريعاً بالدواء، وحينها ينتبه الآخرون ويرمون “البونبونات” العلاجية بحيلهم الخاصة.
تابعت إنعام كجه جي في روايتها، وخلال تلك الجلسات، نقلنا إلى العوالم الداخلية للشخصيات لإبراز معاناتها في بلدها الأم واضطرارها للجوء، ثم في بلادها الجديدة حيث تغرق في اغترابها وتصبح ضحية شركات الأدوية. وبعد سقوط نظام صدام على يد الأميركيين، يغرق حاتم وزوجته في دائرة الاكتئاب من جديد بعد فشل الحلم. وها هو حاتم، في نهاية الرواية، يعود إلى الانكفاء لأنه مصاب بالتوحّد كأنه قدره، أما البقية فيعودون إلى العراق.
وقد يمنح الاغتراب، كما قال إدوارد سعيد، الإنسان قدرة على بناء هوية مركبة جديدة والنظر من الخارج بموضوعية. وهذا ما نلمسه مع سندس ابنة بشيرة، التي تتزوج دانماركياً وتنجح في عملها، ثم حين تعود إلى العراق ترى أن غسل الأدمغة لم يعد بحاجة إلى أدوية؛ فالهواتف الذكية تؤدي الدور يومياً، بينما تواصل دول الشرق إعادة إنتاج أزماتها وصناعة مستهلكين جدد للأدوية. فيما يبقى تحت سطوة العنصرية، فيدفعهم القلق الوجودي إلى الانكفاء على الذات حفاظاً على كينونتهم. وهكذا تصبح الغربة تجربة وجودية عميقة تتنازعهم بين الحنين والصدمة والتهميش.
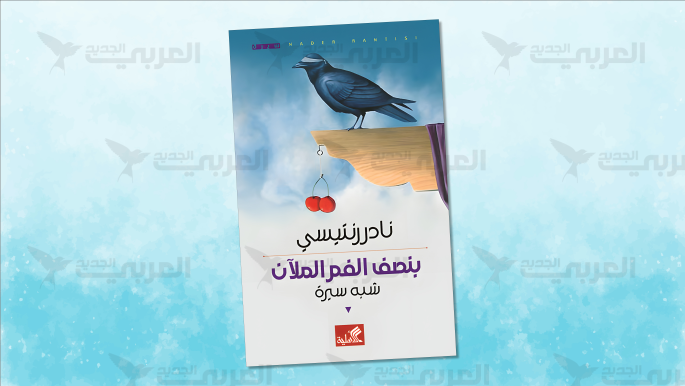
by | Aug 28, 2025 | أخبار العالم
لعلها إحدى قصص وليام سارويان تلك التي تتحدّث عن ولد صغير ينشغل بسنّه المكسورة، فيقوده ذلك إلى مغادرته طفولته والعزلة والتأمّل في الحياة. … ثمّة عيبٌ صغيرٌ في الجسد، لا يلحظه الآخرون، يصرف الكائن الإنساني عما هو عادي في حياة الناس، وربما يقوده إلى مجاهل الإبداع المُغوية.
هنري تولوز لوتريك، أحد أبرز رموز ما بعد الانطباعية، كان قصير القامة فرسم النساء من زاوية مختلفة، أرستقراطياً فرسم فتيات الليل في باريس من أدنى إلى أعلى أحياناً، ما يفسّر ضخامة أجساد النساء في بعض لوحاته أو تركيزه على سيقانهن. يفعل ذلك على طريقته الكاتب الشاب الأردني – فلسطيني نادر رنتيسي في كتابه الفاتن “بنصف الفم الملآن” (الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2022)، الذي يسرد فيه سيرة الطفل الذي كانه، الذي ولد بشفة عليا أرنبيّة، ما جعله يعاني من النطق السليم فترة طويلة من عمره، أو الابتسام كبقية أقرانه، فهو لا يستطيع أن يقف في الصف المدرسي ليقرأ بصوتٍ عالٍ من دون أن يضحك عليه الآخرون. لا يستطيع أن يقرأ قصائد محمود درويش بصوتٍ عالٍ إلا في غرفته الصغيرة.
لم يكفه هذا العيب الصغير، فثمّة أذنٌ لا يسمع بها، وثمّة رحلاته التي لا تنتهي مع والدته إلى مستشفيات الكويت قبل غزوها، وربما كان لطف الممرّضات الآسيويات معه ما منحه العزاء.
كيف تكبر بشفةٍ أرنبيّة، في عائلة فقيرة، لأب شيوعي في الكويت؟ كيف تكون أردنياً في الكويت وكويتياً في الأردن، وتفشل أن تكون فلسطينياً في رام الله وجوارها؟ وكيف تكون مثل بقية الناس؟ تفرح وتحزن، تصرُخ، تحِب وتُحَب، تكره وتهرب، تعود وتنسى وأنت بشفة أرنبيّة؟ كانت الكتابة هي الخلاص والعزاء، بعد عودة إلى الأردن فقد خلالها ذلك الاطمئنان الغامض لمسقط الرأس، لعائلةٍ تكوّنت هناك، وشوارع مشى عليها هناك.
يقدّم رنتيسي في كتابه رصداً حزيناً ومؤسياً لطفولة صاحب الشفة الأرنبية، لانكساراته الصغيرة، ولسيرة أب شيوعي من الطبقة العاملة لا يكفّ عن الغرم بالنساء، والقضايا الخاسرة. أب يعارض غزو الكويت، ويكتب شعارات المقاومة الكويتية على جدران غرفته، ولأم “تُشحَن” إلى الكويت لتتزوّج وتحمل عائلتها على ظهرها في هذه الحياة.
يقود العيب الصغير، بالغ الإحراج لأي طفل، كاتبَ “بنصف الفم الملآن” إلى الكتابة، إلى التأمّل في حياته، ثم سردها، وهذه جرأة كبيرة يُغبط عليها، إذ بفضلها حوّل ما يفترض أن يواجَه بالإنكار إلى ما يستحقّ الإشهار، كأنما يتأمّل صورته في مراياه المتكسّرة، ليرى احتمالاته المتخيّلة تبادله النظر، فالاحتضان والبكاء الصموت قبل الخروج إلى شوارع الناس بوسامة لا يروْنها.
عدم القدرة على النطق السليم جعله ينطق بالكتابة، وتحويل تلك الطاقة المكتومة إلى مجرىً آخر، وذلك ما دفعه إلى اختيار الطريق الوعر: دراسة الصحافة والإعلام، فكيف سيقابل الناس ويسألهم؟ ليس هذا سؤاله بل كيف يعبّر هو عن نفسه، وأن ينطق من دون أن يُنظَر إلى شفته المشقوقة.
يفعل ذلك في كتابةٍ بلغةٍ رفيعة، لغته هو، الصادرة عن آلامه هو، وعالمه هو. عالم الإنسان الصغير في خضم الأزمات الكبرى (السياسية) التي واجهها بأقلّ قدر من الصراخ، لأن نطقه غير سليم، وبأكبر قدر من البلاغة في التوصيف، لأن ثمّة تأملاً ونظراً متكرّراً في كل تفاصيل الحياة، التي هي حياته لا حياة الآخرين، كما هي شفته هو لا شفاه الآخرين، ومكابدته الفقر في العاصمة الأردنية، لا ليكون ويبقى فقط بل ليصبح أباً لمن تبقّوا من عائلته بعد رحيل الأب بالسرطان.
سيعرف في رحلته الصعبة في الحياة وبالغة الإيلام في الداخل أن ليس للفلسطيني وطن، بل “عناوين للنوم”، ما دام يعيش خارجه، وأن آلام الطفل الصغير التي لا يُلتَفت إليها غالباً ستصنع اختلافه، وأن من ينكسر من الداخل ويسمع صوت شظايا كسورِه سيرقّ كالقصائد، كالحب، وسيبدو مقذوفاً خارج التصنيف، وسيسعى إلى عدم التعلّق بشيء بل بفكرة.
يكتب عن مصادفته طفلاً آخر بشفة أرنبية في مدرسته، فيُصاب بالفزع، فيبتعد عنه، ويقف تحت سارية العلم الكويتي ليبكي بدون صوت.
ثمة آلام كبيرة، وحزنٌ يقاوِم طوال الكتاب ألا يتحوّل إلى حزن أسود. ثمّة حبٌّ هنا يحتضن الولد الذي كانه نادر رنتيسي.