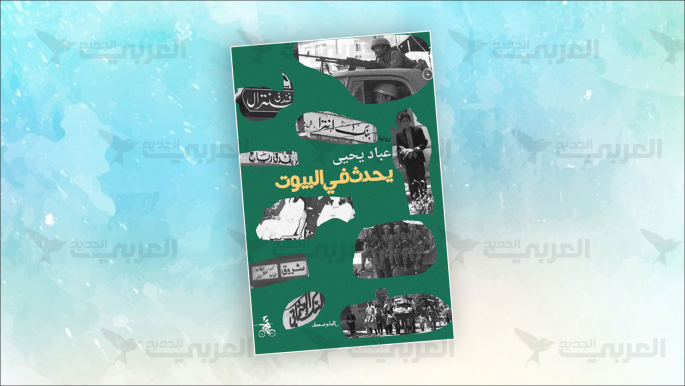
“يحدث في البيوت” أو اللامعقول
تتدافع أسئلةٌ، بعد قراءة رواية عبّاد يحيى “يحدث في البيوت” (منشورات المتوسط، ميلانو، 2025)، تتعلق بلا معقوليّة (ومعقوليّة) وقائع فيها وعلاقات شخصياتٍ فيها ببعضها. وأسئلةٌ كهذه تبقى خارج الأدب، فلم يُخبرنا قدامى نقّاد الأدب ومُحدَثوهم أن “المعقوليّة” من “شروط” العمل الإبداعي، فالوقائع والحوادث في الحياة خارج المنطق العام كثيرة، ولأهل الشعر والسرد وبُناة الحكايات والقصص والمشهديّات أن يختاروا الغريبَ الذي يشاؤون، ليعمّروا نصوصاً وأعمالَاً لهم. ولا يتّصل هذا الكلام، في هذا الموضع، وبصدد خامس روايات عبّاد يحيى، بغرائبيّاتٍ أو عجائبيّاتٍ أو بورخيسيّات، أو بمثل الذي فعله إميل حبيبي لمّا صنع “وقائع غريبة” لمتشائله الشهير، وإنما يتّصل بالأعمال ذات السمْت الواقعي المحض.
فقدَت في النكبة الفلسطينية أُسرٌ أبناءَ لها بقوا (أو تاهوا) في هذا المخيّم أو تلك البلدة أو هذه المدينة، فيما غادرت لاجئةً إلى الخارج أو إلى الضفة الغربية، وغفلت عنهم، وقد تشخّص شيءٌ من هذا في سيناريو وليد سيف لمسلسل “التغريبة الفلسطينية” (2004). غير أن قليلاً من هذا حدث، ولكن شخصيّتين مركزيّتين (من بين خمسةٍ مثلهما في مركزيّتهما) في رواية عبّاد يحدُث معهما هذا، ما قد يدفع إلى القول بلامعقوليّة الحال، إذا جرى القول، مسبقاً، إن الأدب، في واحدٍ من تعريفاتٍ له، تمثيليّ، سيّما إذا مضت سرودٌ في روايةٍ أو قصّةٍ أو مسرحيةٍ في مجرىً واقعيٍّ متعيّن المكان والزمان. يزيد من وجاهة زعم اللامعقولية هذه أنّ السرد في “يحدث في البيوت”، يتناوب بين ضمير الأنا الساردة، وهو خطّاطٌ يصبح خبيراً في الطباعة وفنونها وصناعاتها (نعرف اسمَه جميل في الربع الأخير من النص)، وضمير السارد العليم الذي يحكي عن هالة، الصغيرة التي تلقى نفسَها من دون أهلها الذين هاجروا، وتؤويها جمعيةٌ ستعمل فيها، لتصبح، مع السنوات، مديرةً لها. ويرعى شؤونَها محام يستخرج لها وثائق شخصيّتها. ثم تنشأ علاقةٌ خاصّة بينهما تطول عقوداً. وبعض اللامعقوليّة هنا في أن السارد العليم لا يتذكّر أن لهالة أهلاً قد يسألون عنها، أو تصل إليها أخبارٌ عنهم، أو تحاول هي تسقّط شيءٍ بشأنهم، أقلّه كما “أبلغنا” الأنا السارد، الخطّاط عن أهله الذين ارتحلوا إلى الأردن، ثم وقع أن أختاً له متزوّجةً في الضفة الغربية تواصلت معه، وصار يزور منزلها، وتهيئ له طبخة “اليخنة”.
كأن عبّاد يحيى أراد شخصية هالة امرأةً طموحةً، جريئة، وصاحبة طفولة تائهة، وقد نجح في بناء تكوينها هذا، وفي أن “يُقنع” القارئ بوقائع تخصّها قد تبدو غير معقولة، مثل مغادرتها الجمعية فجأة، للتفرّغ للمحامي، والذي تبدو علاقتهما على كثيرٍ من اللامعقول، فمع معرفة أن رام الله الفضاء المكاني لمسار الرواية، يبقى غير عاديٍّ أن تعتاد هالة على زيارة المحامي (سنعرف في المختتم أنه مسيحي)، وإنْ فارقُ العمر بينهما ليس قليلاً، في منزله في كل الأوقات. وعندما يترافقان في زيارةٍ طويلةٍ إلى شمال فرنسا، ثم الولايات المتحدة، من دون زواج، فإن درجة أعلى من اللامعقول ستحضُر. وإذ تأتي هالة نفسُها على حبّ جميل لها، وتردّده، وضعف مبادرته، “يُهندس” الكاتب شخصيَّتها، بما يجعلنا نسأل أنفسنا ما إذا كان إحساسُ هذه المرأة بأنوثتها منقوصاً، أو ليس كما المعهود في النساء (سيّما في الروايات؟). فباستثناء بهجتها بجسدِها وساقيْها عندما تكون بتنّورةٍ قصيرةٍ في حفل، وتُلتقط لها صورةٌ لا تنشرها في مجلة الجمعية، يحتفط بها جميل، لا نستشعر مقادير أوضح من أنوثة امرأةٍ لجسدِها استحقاقاتُه، ولا نصادف حيرةً فيها ما إذا كانت تريد الزواج أم أن لها موقفاً حادّاً منه، وهي التي تواظب على علاقتها، غير المشوبة بأي حرام، على ما يظهر، حتى وفاته.
قد ينضاف لا معقولٌ آخر، في انتقاء نموذجٍ، نافر، من شباب التنظيمات الفلسطينية وناسها، خالد الذي يعتقله الاحتلال، ويبدو شديد الثورية في وطنيّته، ثم يختار الخطّاط جميل لقتل المحامي، فيسلّم هذا سمّاً إلى هالة التي لا تفعل… ما الذي أراده عبّاد من هذا “الانتقاء” الذي يوحي بإدانةٍ ما، وقد برعت روايتُه، بإبداعٍ غزير، في تظهير مسارات الزمن الوطني والاجتماعي الفلسطيني من خلال مسار المطبعة، منذ بُعيْد النكبة لمّا كانت محلّ خطوط إلى ما بعد “أوسلو” والحواسيب الحديثة. وبرعت في تظهير شخصيّة جميل، مشبَعةً، ممتلئةً بتفاصيل غنيّة، وبعاديّتها أيضاً. وبرعت في إثارة التباسٍ فينا، ما إذا كانت لامعقوليّة الوقائع وعلاقات الشخصيات في أي روايةٍ توسّلاً فنّياً لا يجيز السؤال عن المعقول وعكسه، أو كانت موضع مؤاخذةٍ على العمل عموماً؟ لا أعرف.

