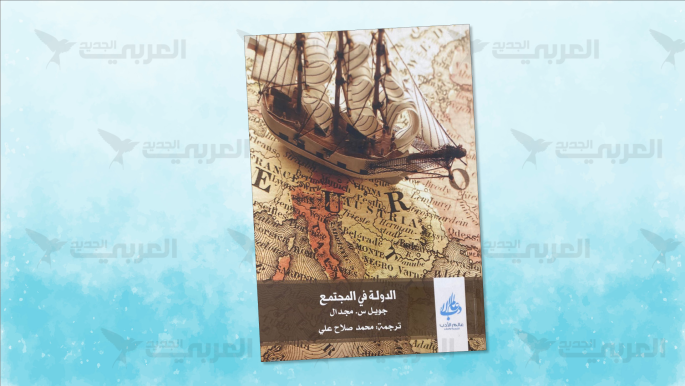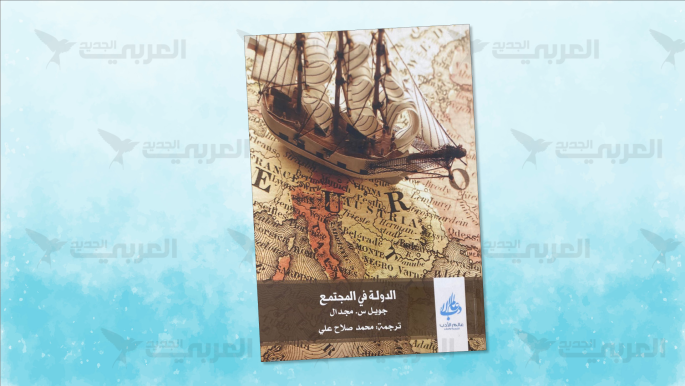
by | Sep 9, 2025 | أخبار العالم
يمثّل كتاب جويل مجدال “الدولة في المجتمع: دراسة كيف تحول الدولة والمجتمعات وتشكل بعضها بعضاً” (ترجمة محمد صلاح علي، عالم الآدب للبرمجيات والنشر والتوزيع، القاهرة، 2017) محاولة جذرية لإعادة التفكير في مفهوم الدولة ومكانتها داخل الدراسات المقارنة للسياسة.
لم يكن الكتاب مجرّد إضافة للنقاش النظري، بل شكّل تحوّلاً نوعيّاً في طريقة النظر إلى الدولة: كيف نفهمها، وكيف ندرس تفاعلها مع المجتمع؟ على خلاف التعريف الكلاسيكي لماكس فيبر، الذي رأى الدولة الكيان الذي يحتكر العنف المشروع داخل الإقليم، قدّم مجدال رؤية أكثر تعقيداً: الدولة ليست مجرّد هيكل أو مؤسّسة، بل هي حقل متشابك من الصور والمآذارات. تمثل الصور ما تنتجه الدولة عن نفسها: الأعلام، الشعارات، الدساتير، والخطابات الرسمية التي تعكس سيادتها المزعومة. أما المآذارات فهي قدرة الدولة على جعل الناس يتبعون قواعدها في حياتهم اليومية. يوضح هذا التمييز الفجوة بين ما تدّعيه الدولة وما تنجح فعليّاً في فرضه، ويكشف أن الدولة ليست قوة مطلقة، بل هي طرفٌ في شبكة معقدة من الصراعات الاجتماعية والسياسية، متأثّراً بهذا التعريف بعالمي الاجتماع الفرنسيين؛ ميشيل فوكو في تأطيره مفهوم الصورة وبيير بورديو في تأطيره مفهوم الحقل في العلوم الاجتماعية.
لم تتشكّل هذه الرؤية في فراغ؛ فقد تشكّل وعي مجدال أولاً من خلال مقاربة إدوارد شيلز عن “المركز والمحيط”، التي تصوّر الدولة كمركز يمتلك القوة الرمزية والقانونية لإخضاع المجتمع التقليدي. اعتمد مجدال هذا التصور في بداياته، إلا أن هزيمة عام 1967 أظهرت له محدوديته، فإسرائيل، رغم قوتها العسكرية والبيروقراطية، لم تنجح في إخضاع المجتمع الفلسطيني أو فرض هيمنتها المطلقة، ما دفعه إلى إعادة النظر في نموذج المركز– المحيط (المقاربة المنهجية التي طوّرها إدوارد ميشلز وكان مجدال يتبنّاها)، والبحث عن فهم أكثر دقة لصراع الدولة مع القوى الاجتماعية على الشرعية والهيمنة.
ليست الدولة قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها
كما تأثر مجدال، في بداياته، بصموئيل هنتنغتون، خصوصاً خلال دراسته العليا في السياسة المقارنة، ونظرياته حول المؤسّسات السياسية واستقرار الأنظمة. ركّز هنتنغتون على دور المؤسسات في ضبط الصراعات وتحقيق استقرار الدولة، وهو ما بدا مقنعاً لمجدال في البداية. لكنه سرعان ما اكتشف أن التركيز على المؤسّسات وحدها يغفل الصراعات المجتمعية الفعلية والتفاعلات بين الدولة والقوى الاجتماعية، وهو ما دفعه لاحقاً إلى نقد محدودية هذا الطرح وتطوير رؤيته الخاصة، التي تراعي الدولة بوصفها شبكة متشابكة من الصور والمآذارات تتنافس مع قوى متعدّدة في المجتمع.
في هذا الإطار، جاء مجدال رد فعل مباشراً على جدل واسع في السياسة المقارنة، فالمرحلة السلوكية، بقيادة ديفيد إيستون وغابرييل ألموند، ألغت الدولة من التحليل، وركزت على “النظام السياسي” كآلة تحلل المدخلات والمخرجات دون النظر إلى خصوصية الدولة أو تاريخها المؤسّسي. ومع نهاية السبعينيات، جاءت موجة “استعادة الدولة” Bringing the State Back In، لتعيد الدولة إلى صدارة التحليل فاعلاً قادراً على فرض إرادته على المجتمع. في هذا السياق، ظهرت مقاربة الكوربوراتية، التي تصوّر الدولة منظّماً للمجتمع عبر قنوات رسمية شبه مؤسّساتية، مثل النقابات والجمعيات المهنية، فيما أشار غييرمو أودونيل إلى “البيروقراطية السلطوية” في أميركا اللاتينية، حيث الدولة العسكرية – البيروقراطية تفرض هيمنتها من أعلى، مطبّقة نظم السيطرة على المجتمع.
اشتبك مجدال مع كلا النموذجين (السلوكي وما بعد السلوكي)؛ فهو لم يكتفِ بالرفض السلوكي الذي ألغى الدولة، ولم يقتنع بالتصوّر المطلق لما بعد السلوكية والكوربوراتية. بل رأى أن الدولة ليست قوة عليا مطلقة، بل هي طرفٌ في صراع متواصل مع قوى متعدّدة – عشائر، طوائف، حركات دينية، شبكات اقتصادية غير رسمية، ومنظّمات مدنية – تنافس على فرض قواعدها وشرعيتها. وهكذا صاغ جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف.
يستدعي هذا التحليل، أيضاً، أفكار غرامشي، إذ يوضح أن الهيمنة لا تقوم على القوة المادية وحدها، بل على القدرة على إنتاج منظومة قيمية تجعل السلطة مقبولة. الدولة تسعى إلى فرض هيمنتها عبر التعليم، القانون، الإعلام والمؤسّسات الرمزية، بينما تسعى الجماعات الاجتماعية إلى إنتاج هيمنتها الخاصة عبر الدين، العائلة، الشبكات التقليدية أو الاقتصاد غير الرسمي. بذلك يصبح الصراع على الشرعية والمعنى جزءًا من الصراع على القوة، ويظل فهم الدولة مستحيلاً بمعزل عن المجتمع.
الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي
يكتسب تحليل مجدال أبعاداً أعمق عند مقارنته بفكر محمد عابد الجابري لا سيما كما طرحه في كتابه “العقل السياسي العربي”، فالجابري أبرز أن العقل السياسي العربي يتأثر باللاشعور السياسي والمخيال الاجتماعي، بحيث يستحضر التاريخ في الحاضر ويعيد إنتاج أنماط الهيمنة والصراع القديمة، ويظهر أن الدولة العربية ليست مجرّد مؤسّسة قائمة بذاتها، بل محصلة لتفاعلات القوى الاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك يتقاطع بدقة مع مجدال، الذي أشار إلى الفجوة بين الصورة والمآذارات، أي ما تدّعيه الدولة من سيادة وما تستطيع فعليّاً فرضه على المجتمع. ومن هذا المنطلق، تمنحنا مقاربة مجدال أدوات لفهم هشاشة الدولة العربية، حيث تتنافس الجماعات المختلفة على فرض قواعدها وضبط القيم والمعايير الاجتماعية، وتظلّ الشرعية متعدّدة وغير مستقرّة.
حين نطبق هذا على الواقع العربي، يظهر مدى أهمية مقاربة مجدال. ففي العراق، تتنازع الدولة والمليشيات الطائفية على الولاءات والقواعد. في لبنان، تآذار الطوائف والأحزاب سلطة موازية، بينما تحوّلت الجماعات المسلحة في اليمن وليبيا إلى بديل حقيقي للدولة، ففي هذه الحالات، لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها العسكرية أو الأمنية فقط، بل بقدرتها على جعل قواعدها المرجعية هي التي يلتزم بها الناس طوعاً.
لا تقتصر أهمية هذا التحليل على الجنوب فقط. ففي الغرب، تكشف تحوّلات القرن الحادي والعشرين عن محدودية الدولة: صعود الشعبوية، تراجع الثقة بالمؤسّسات، قوة الشركات الرقمية العملاقة، والحركات الاجتماعية العابرة للحدود. ويعكس ذلك كله أن “المآذارات” لم تعد حكراً على الدولة، حتى لو بقيت “الصورة” قوية.
صاغ مجدال جوهر مقاربته: الدولة والمجتمع معاً، شبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، حيث لا هيمنة مطلقة لأي طرف
تزداد أهمية هذه المقاربة عند النظر إلى أزمة شرعية الدولة في العالم العربي، فالدول الأوروبية استطاعت، عبر مفهوم الدولة – الأمة، أن تؤسّس لعقد اجتماعي نسقي متكامل يجمع بين الشرعية القانونية والسياسية والثقافية. في المقابل، تظل الدولة العربية في حالاتٍ كثيرة رهينة مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي، حيث لا تتأسّس الشرعية على إجماع شعبي مستقر، بل على سلطة تاريخية وبنى مادية، وغياب الوعي السياسي المدني، كما يشير محمد عابد الجابري. ومن هذا المنظور، يقدّم مجدال أدوات حيوية لفهم هذه الهشاشة، بإبراز أن الدولة ليست كياناً مطلقاً، بل هي فضاء متصارعٌ مع المجتمع، حيث تتنافس الجماعات والمجموعات على فرض قواعد الضبط الاجتماعي والقيمي، وتتقاطع الصورة مع المآذارة لتنتج شرعيات متعدّدة وغير مستقرة.
في المحصلة، يقدّم مجدال حلقة ثالثة في تطوّر السياسة المقارنة: بعد تغييب الدولة سلوكيّاً، واستعادتها مطلقة في ما بعد السلوكية والكوربوراتية، جاء ليعيد الدولة والمجتمع معاً إلى قلب التحليل، فضاءً واحداً للصراع على الشرعية والهيمنة. ومن هنا يكتسب كتابه “الدولة في المجتمع” قيمته المرجعية، ليس فقط لفهم هشاشة الدولة العربية، بل أيضاً لتفسير التحولات الحديثة في العالم، من خلال إدراك الدولة والمجتمع كشبكة متشابكة من الصور والمآذارات والقوى المتنافسة، لا ككيان واحد منفصل أو متفوق دوماً.
يمثل كتاب “الدولة في المجتمع…” رؤية ديناميكية تمكّن الباحث من فهم تعقيدات الدولتين، العربية والغربية على حد سواء، وتقديم تحليل قادر على استيعاب هشاشة الدولة، صراعها مع المجتمع، وتعدّد فاعليتها، بعيداً عن النظريات الأحادية التي إما ألغت الدولة أو بالغت في هيمنتها، ليصبح مجدال مرجعاً ضروريّاً لكل دراسة مقارنة تبحث عن فهم معمّق للدولة والمجتمع في عالم معقّد ومتغير.

by | Sep 8, 2025 | أخبار العالم
بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد، سقط نظام الأسد الإجرامي، ووجد السوريون أنفسهم أمام لحظة فارقة في تاريخهم السياسي، حملت معها وعوداً كبيرة ببناء دولة جديدة، عادلة، تكسر مركزية السلطة، وتعيد الاعتبار للحقوق والحرّيات التي سُحقت عقوداً. كانت الآمال معلّقة على أن تكون هذه المرحلة بداية فعلية لقطيعة مع الماضي، لا مجرّد تبديل في الوجوه، بل تأسيساً لدولة تُدار بمنطق المؤسّسات، لا بمنطق الغلبة.
ومع تولية أحمد الشرع رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، بدأت مرحلة جديدة من التحدّيات، تتعلق بالبنية الهشّة للسلطة الجديدة، وبالمأمول منها شعبياً، الذي يفوق بكثير ما يمكن تحقيقه في الظروف الراهنة. وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على سقوط نظام الأسد، لم تتمكن السلطة الجديدة من بناء مؤسسات مستقلة قادرة على إدارة الدولة وفق منطق القانون والمواطنة. بل تشير مظاهر الفوضى، والانقسامات، وتكرار الانتهاكات، إلى أن السلطة لا تزال عاجزة عن التحوّل من حالة الثورة إلى حالة الدولة.
ولا يرتبط هذا العجز فقط بصعوبات المرحلة الانتقالية، بل يتجذّر في طبيعة التكوين السياسي والعسكري للسلطة نفسها، فهي ليست جسماً موحداً، بل تتكوّن من فصائل متعدّدة، لكل منها تاريخها وأدواتها ومناطق نفوذها، ما يجعل من التنسيق الداخلي تحدّياً يومياً، ويُضعف قدرتها على فرض القانون أو ضبط الأداء. الفصائلية التي كانت مبرّرة في سياق مقاومة نظام الأسد، باتت اليوم عائقاً أمام بناء سلطة وطنية، وتُنتج حالة من التنازع والصراع الداخلي، تُضعف هيبة الدولة وتُربك علاقتها بالمجتمع.
إذا استمرّت المآذارات الإقصائية، ستتآكل شرعية السلطة تدريجياً، وستتحوّل إلى عبءٍ على نفسها، بدل أن تكون أداة للتغيير
إلى جانب ذلك، جاءت معظم العناصر التي كلفت تولي الأمن من خلفيات قتالية، ولم تُمنح فرصة التعليم أو التدريب المدني، بعد سنوات من العيش تحت القصف وفي الخيام وفي ساحات القتال. وهذا الواقع يجعل من مهمة إدارة شؤون الناس تحدّياً كبيراً، ويُنتج أداءً هشّاً، لا يستند إلى خبرة مؤسّساتية، بل إلى منطق القوة والارتجال. ومع حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، يصبح من الصعب على السلطة، مهما كانت نياتها، أن تنهض وحدها من تحت الركام، من دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، ومن دون دعم دولي فعّال، ومن دون خطّة واضحة تتجاوز الشعارات إلى السياسات الواقعية.
في ظل هذا الواقع المرتبك، لا تقتصر التحدّيات على ضعف الأداء الداخلي، بل تتعقّد بفعل وجود قوى متعدّدة تسعى إلى تقويض سلطة أحمد الشرع، وإن اختلفت دوافعها وأدواتها. ولا تنتمي هذه القوى إلى معسكر واحد، بل تتوزّع بين أطراف داخلية وخارجية، تتقاطع مصالحها عند نقطة واحدة، إضعاف السلطة الجديدة، أو دفعها نحو الفشل.
الفئة الأولى: من يمكن وصفهم بـ”المطبلين” أو “الساكتين عن الأخطاء”، وهم الذين يحيطون بالسلطة من دون أن يقدّموا لها النصح أو النقد، بل يزيّنون لها الأداء، مهما بلغ من التردّي. هؤلاء لا يُضعفون السلطة من الخارج، بل من الداخل، عبر إيجاد صورة زائفة عن النجاح، وعزل القيادة عن نبض المجتمع. الولاء الأعمى لا يصنع دولة، بل يُنتج سلطة متغطرسة ومنغلقة، تفقد تدريجيًا قدرتها على الإصغاء والتصحيح.
الثانية: تضم من يبالغون في تصيّد الأخطاء، ويحوّلون كل إخفاقٍ إلى مادّة للتشكيك والهجوم، من دون تقديم رؤية بديلة واضحة. يُغرق هذا الفريق الرأي العام في اليأس، ويُغذّي الانقسام الاجتماعي والسياسي، ويُساهم في إيجاد بيئة مشحونة، لا تسمح بالحوار ولا بالتدرّج في الإصلاح. ورغم أن النقد مشروعٌ وضروري، إلا أن تحويل بعضه إلى أداة للهدم يُفقده قيمته، ويُحوّله إلى جزءٍ من الأزمة، بدل أن يكون مدخلاً إلى الحل.
السلطة التي تُدار عبر مجموعة ضيقة، وتُغلق أبوابها أمام الأصوات المستقلة، لا يمكن أن تصمُد طويلًا
الثالثة: القوى الخارجية التي فقدت نفوذها في سورية بعد سقوط نظام الأسد، وفي مقدّمتها إيران والمليشيات العراقية واللبنانية، التي كانت (ومعها روسيا) لها اليد الطولى في تقرير المصير السوري سنوات مضت. ترى هذه الأطراف في الإدارة الجديدة تهديداً لمصالحها، وتسعى لإعادة تدوير نفوذها عبر أدوات متعدّدة: الإعلام، التمويل، الضغط الدولي، أو حتى تحريك خلايا داخلية. ما يجمع هذه القوى رفضها أي سلطة لا تخضع لمنطق المحاور، أو لا تضمن استمرار امتيازاتها في سورية ما بعد الأسد.
في قلب هذا المشهد، تبرُز مسألة الشرعية بوصفها التحدّي الأخطر الذي يواجه السلطة الجديدة، فالشرعية لا تُصنَع بالقوة، ولا تُفرض بالهيمنة، بل تُبنى على المصداقية، وعلى قدرة السلطة على تمثيل الناس، وخدمتهم، والاستجابة لتطلعاتهم. لا يملك الرئيس أحمد الشرع، الذي اختارته الفصائل حلّاً توافقياً، شرعية دستورية، لكنه يملك فرصة نادرة لإعادة تعريف السلطة، وتأسيس نموذج جديد في الحكم، إذا ما امتلك الجرأة على مراجعة الأداء، والانفتاح على النقد، وتوسيع دائرة الشراكة.
السلطة التي تُدار عبر مجموعة ضيقة، وتُغلق أبوابها أمام الأصوات المستقلة، لا يمكن أن تصمُد طويلًا، حتى لو حافظت على السيطرة العسكرية، فالمجتمعات لا تُدار بالقوة وحدها، بل بالثقة، وبالقدرة على بناء مؤسّسات تحظى بالاحترام، وتُنتج سياسات عادلة، وتُحاسب نفسها قبل أن تُحاسب الآخرين. وإذا استمرّت المآذارات الإقصائية، ستتآكل شرعية السلطة تدريجياً، وستتحوّل إلى عبءٍ على نفسها، بدل أن تكون أداة للتغيير.
بناء الدولة لا يبدأ من السيطرة، بل من الثقة، ولا يُنجز بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة التي تُعيد وصل السلطة بالمجتمع، وتُحوّلها من عبء إلى أداة للتغيير
ورغم قتامة المشهد، هناك خيط رفيع من الأمل، يمكن البناء عليه إذا توفرت الإرادة السياسية والجرأة على التغيير. بدأت بعض الأصوات داخل السلطة تُدرك أن الاستمرار في النهج الحالي لن يؤدّي إلا إلى مزيد من العزلة والتآكل، وأن الإصلاح لم يعد خياراً تجميلياً، بل ضرورة وجودية. لكن هذا الخيط الهشّ لا يمكن أن يتحوّل إلى مسار فعلي إلا إذا توافرت شروط واضحة أهمها: الاعتراف بالأخطاء، لا التغطية عليها. الانفتاح الحقيقي على المجتمع والكفاءات والخبرات، التي تمتلك رؤى وطنية ولا ترتبط بأجندات خارجية. اتخاذ قرارات ملموسة تُعيد بناء الثقة، من خلال فرض السيطرة الكاملة على الفصائل المتحالفة مع السلطة، ووقف حالة التنازع الداخلي التي تُضعف الأداء وتُربك القرار، فبناء الدولة لا يمكن أن يتم في ظل ازدواجية السلطة، أو تعدد مراكز القرار، أو استمرار منطق السلاح في إدارة الشأن العام. تفعيل دور المجتمع المدني، الذي يُشكّل ركيزة أساسية لأي مشروع وطني. ولا يقتصر هذا الدور على تقديم الخدمات أو تنظيم المبادرات، بل يمتدّ إلى مراقبة الأداء، واقتراح السياسات، وإيجاد فضاء عام يسمح بالنقاش والتعدّدية. تفعيل دور الإعلام، الذي ظل سنواتٍ أداة للتحريض أو التمجيد، وتحويله إلى منصّة للتنوير، تُسلّط الضوء على القضايا الحقيقية، وتُساهم في بناء وعي نقدي، لا في تغذية الانقسام.
تبنّي مسار واضح للعدالة الانتقالية، يُعيد الاعتبار للضحايا، ويُوثّق الانتهاكات، ويُؤسّس لمحاسبة عادلة لا انتقامية. ومواجهة الماضي بشجاعة تُؤسّس لشرعية أخلاقية وقانونية تُحصّنها من السقوط. العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً، بل شرط أساسي للسلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وبناء مؤسسات تحظى بثقة الناس، وتُعيد وصل المجتمع بالدولة.
باختصار، لا يكفي إسقاط النظام المجرم، بل يجب أن تنهض البدائل على أسس جديدة، تُعيد الاعتبار للناس، وتُعيد تعريف السلطة بوصفها خدمة لا هيمنة، ومسؤولية لا امتيازاً. والسلطة الجديدة أمام اختبار تاريخي: إما أن تختار طريق الإصلاح الحقيقي، وتُفعّل شروط التحوّل السياسي والمؤسساتي، وفي مقدمها العدالة الانتقالية، وإما أن تستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة تُعيد إنتاج الاستبداد الذي ثار عليه السوريون، فبناء الدولة لا يبدأ من السيطرة، بل من الثقة، ولا يُنجز بالشعارات، بل بالقرارات الجريئة التي تُعيد وصل السلطة بالمجتمع، وتُحوّلها من عبء إلى أداة للتغيير.

by | Sep 6, 2025 | أخبار العالم
وقّعت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات، في خطوة قالت اللجنة إنها تأتي في إطار حرصها على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية. وذكرت اللجنة في بيان، اليوم السبت، أن المنظمات المشاركة في المذكرة شملت وحدة دعم الاستقرار (SSU)، ومنظمة اليوم التالي (TDA)، ووحدة المجتمعات والوعي المحلي (LACU)، ومنظمة النهوض بالمجتمع المدني (GLOCA)، ورابطة الشبكات السورية (SNL).
وبحسب البيان، تضمنت المذكرة التزام هذه المنظمات بإجراء تدريبات وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، وتقديم خبرة فنية في مجالات حل النزاعات البسيطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وسلاسة. كما أعلنت اللجنة اعتماد برنامج تدريبي خاص باللجان الفرعية، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، وذلك لضمان وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.
وتسعى اللجنة العليا من خلال هذه الشراكات إلى إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل أوسع في العملية الانتخابية، في ظل مناخ سياسي جديد تشهده البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/كانون الأول 2024، وتزايد المطالب الشعبية بترسيخ آليات ديمقراطية تضمن مشاركة أوسع وتمثيلاً أكثر عدالة.
وقال منذر سلال، المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، لـ”العربي الجديد”، إن وحدة الدعم والاستقرار ستقوم بتنفيذ عملها على مرحلتين: المرحلة الأولى تتعلق بتدريب اللجان الفرعية الانتخابية، أما المرحلة الثانية، فستكون لتدريب الهيئات الناخبة. وتهدف الوحدة إلى “تعزيز قدرات اللجان الانتخابية، خاصة أن العملية الانتخابية في سورية في هذه المرحلة تُعد الأولى من نوعها بعد التحرير وانتصار الثورة السورية، وما يحيط بها من صعوبات ونموذج مختلف عما كان عليه الوضع سابقاً، حيث يجرى الآن تعزيز دور الكفاءات والوجهاء والأعيان”.
ونظراً إلى ما تمر به سورية من صعوبات حالت دون إجراء انتخابات شاملة وعامة، قال سلال إن وحدة دعم الاستقرار، بالإضافة للمنظمات الشريكة، ستقوم بتنفيذ التدريبات استناداً إلى المراسيم والقوانين التي سنتها اللجنة العليا للانتخابات في ما يخص العملية الانتخابية، وذلك لضمان أن تكون جميع اللجان الفرعية على صفحة واحدة، مضيفاً: “بطبيعة الحال، فإن هذه الخطوة تعزز نزاهة العملية الانتخابية، لأن كثيراً من الأخطاء التي قد ترافقها تنشأ إما عن جهل أو عن خطأ غير مقصود، لا سيما على مستوى اللجان الانتخابية. ومن هنا، فإننا نضمن على الأقل أن الدولة السورية، ولأول مرة، قد أتاحت لمنظمات المجتمع المدني تعزيز قدرات هذه اللجان، فضلاً عن المسؤولية التي ستقع على عاتق الهيئة الناخبة. فالتدريبات التي ستخضع لها ستسهم في تعزيز قدراتها، ووضع المسؤولية بين أيديها لاختيار من تراه مناسباً لتمثيلها في مجلس الشعب، كما ستضمن تقليص نسبة الأخطاء والإشكاليات الناتجة عن عدم المعرفة”.
وأوضح سلال أن الأخطاء أو التجاوزات الانتخابية، التي قد تحصل غالباً، تكون بسبب عدم الإلمام بالقوانين والإجراءات، سواء من جانب اللجان الانتخابية أو من جانب الهيئة الناخبة “وهذا بالضبط ما ستعالجه منظمات المجتمع المدني من خلال التدريبات، حيث ستُقلّص هذه الأخطاء إلى أبعد حد. وإلى جانب ذلك، فإن المتابعة العملية لمجريات العملية الانتخابية ستسهم بدورها في الحد من أي تجاوزات أو إشكالات قد تحدث أثناء سيرها”.
وشدد سلال على أن هذه العملية والشراكة بين منظمات المجتمع المدني واللجنة العليا للانتخابات تُعد الأولى من نوعها في تاريخ سورية. فقد “كانت الانتخابات في السابق محصورة بأعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، فهم كانوا المراقبين والناخبين والمرشحين في الوقت نفسه”. أما اليوم، فإن إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في المتابعة والتطوير والتدريب ورفع القدرات ومراقبة سير العملية الانتخابية هو تطور نوعي سيُبنى عليه مستقبلاً. مرجحاً أن يكون هناك لاحقاً “دور أكبر وأكثر عمقاً لهذه المنظمات على المستويات الرقابية والتوعوية، بما يسهم فعلاً في الوصول إلى مجالس برلمانية لمجلس الشعب تمثل الشعب السوري بحق، وتتمتع بوعي سياسي ومجتمعي أكبر”.
ولفت سلال إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الوعي السياسي والعام هو ما تحتاجه سورية في المرحلة المقبلة، وهو ما يضمن أيضاً زيادة شفافية العمليات الانتخابية، سواء في انتخابات مجلس الشعب السوري أو المجالس البلدية أو غيرها، معتقداً أن هذه الخطوة المتقدمة والفريدة من نوعها ستفتح الباب أمام بناء تجارب أوسع وأعمق في المستقبل.