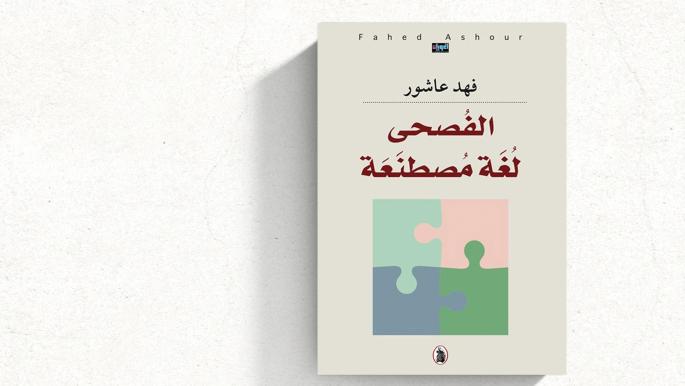by | Sep 9, 2025 | أخبار العالم
شكلت الدراما السورية والمصرية منذ عقود محورًا رئيسًا في صناعة الفن العربي، حيث تتناوبان على احتلال صدارة المشهد الجماهيري والإعلامي.
وإذا كانت مصر قد عُرفت تاريخيًا بأنها “هوليود الشرق”، فإن سوريا نجحت خلال العقود الماضية في انتزاع مكانة مرموقة عبر أعمالها التاريخية والاجتماعية التي تميزت بالعمق والواقعية.
“مواجهة مباشرة”
لكن هذا التنافس لم يكن يومًا عدائيًا، وانعكس غالبًا في شكل تكامل وتبادل خبرات. ومع هذا فهو لم يخل أحيانًا من مشاحنات وتصريحات مثيرة للجدل تضع الوسط الفني في مواجهة مباشرة.
وأحدث مثال على هذا التنافس ما جرى بعد انتشار مقطع فيديو للفنان السوري سلوم حداد الذي علّق في إحدى الندوات على طريقة نطق عدد من الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى، بأن قلة فقط في مصر برعوا في النطق السليم.
واستشهد الفنان السوري بالراحلين عبد الله غيث ونور الشريف، قبل أن يقلد بأسلوب ساخر جملة باللهجة المصرية قائلًا: “وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟”، وهو ما أثار ضحكات الحضور لكنه فتح بابًا واسعًا للجدل.
وقوبلت تصريحات سلوم حداد بموجة غضب من فنانين وإعلاميين مصريين.
اعتذار من الفنان السوري وتفاعل على مواقع التواصل
ورد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باستشهاد شعري موجه لحداد: “يا أيها الرجل المعلم غيره، هلّا لنفسك كان ذا التعليم”، داعيًا ضمنيًا إلى التواضع في النقد.
وكتب الفنان محمد علي رزق عبر “فيسبوك”: “هناك فنانون مصريون كثيرون يتحدثون الفصحى بإتقان كامل، ويمكنك مشاهدة أعمال يحيى الفخراني مثل (الملك لير) لتتأكد”.
كذلك، عبّر فنانون آخرون مثل عمرو محمود ياسين عن رفضهم لما اعتبروه “انتقادًا غير منصف”.
وإزاء تصاعد الجدل، بادر سلوم حداد إلى تقديم اعتذار رسمي أوضح فيه أن حديثه كان فنيًا بحتًا ولم يكن الغرض منه الإساءة للفن المصري أو لرموزه، وقد أكد احترامه الكبير للفنانين المصريين وتجربتهم الرائدة.
وأكد أشرف زكي نقيب الفنانين المصريين قبول الاعتذار، مذكرًا بأن الروابط التاريخية والفنية بين سوريا ومصر أكبر من أن تهزها مواقف عابرة، ومستشهدًا ببيت شعر: “زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا.. أبشر بطول سلامة يا مربع”.
وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع جدل تصريح حداد سلوم.
فكتب عبد الرحمن وهو متخصص في الآداب واللغات: “انتقاد الممثل السوري سلوم حداد للممثلين المصريين بأنهم لا يجيدون الفصحى ولا يستطيعون نطق الجيم المشبعة انتقاد سخيف لا يخلو من التنمر على شعب خرّج خيرة القراء والشعراء والأدباء في العالم العربي الحديث. ثم إن حرف الجيم “القاهري” (= القيف) حرف أصيل في اللغة العربية واللغات السامية ومستعمل في كل الدول العربية بما في ذلك سوريا”.
وقالت نجلاء الثقفي: “قامة فنية مثل سلوم حداد استغرب كمية الهجوم عليه لأنه نطق بالحقيقة. فعلًا كلامه منطقي وحقيقي مع احترامي لإخواننا في مصر أفضل من أجاد اللغة العربية هم السوريون وهذا لا يقلل من الفن المصري. يوجد فنانون مصريون أجادوا النطق الصحيح للغة العربية”.
وكتب رضا بسيوني: “لو كان سلوم حداد اختص بكلامه على الممثلين المصريين حاليًا الناس كان من الممكن تجاوز كلامه لأن الجيل الحالي فعلًا لا له في الفصحى ولا العامية. لكنه عمّم وحذف تاريخ طويل كانت الإذاعة والتلفزيون المصريان بتنتج مسلسلات تاريخية عظيمة”.
هذا في حين قال فارس قبلان: “يبقى الفن رابطًا جامعًا بين الشعبين، قدمت مصر وسوريا معًا عشرات الأعمال المشتركة واحتضن كل بلد نجوم البلد الآخر. ما يؤكد ذلك هو سرعة تجاوز الأزمة الأخيرة بروح من الاحترام المتبادل والاعتراف بأن المنافسة، مهما بلغت حدتها، لا تلغي الشراكة التاريخية في صنع هوية الدراما العربية”.

by | Sep 7, 2025 | أخبار العالم
لم يكن محمد عابد الجابري على صواب تام عندما كتب في 1973 عن التعريب في المغرب، ولم تكن القضية الأمازيغية بعدُ قد اكتست أي اعتبار مفهومي حتى بالنسبة إلى مثقفيها الرواد الذين التفوا حول جمعية التبادل الثقافي (1967). ولذلك طالب، في إطار مشروع تعليمي متكامل يقترحه لمغرب التحوّل الديمقراطي، بوجوب “إماتة” الفرنسية، ولو أنها لغة حضارة وثقافة، والأمازيغية معها (ثلاث لهجات أو دوارج محلية) والعربية الدارجة نفسها التي يتكلم بها عامة الناس. أما الاعتبارات التي قلّلت، كما أرى، من صواب الرأي، رغم أنه كان ذا نفحة تقدّمية قومية، فكامنة في أنه لم يصمُد طويلاً في وجه التطور التاريخي الذي تطوّرت فيه تلك “اللهجات”، وانتهى إليه منظور التعريب نفسه.
أول ما يلاحظ، بصورة عامة، أن المطالبة بالتعريب في مدى 50 سنة تقريباً، وفي بُعدٍ من المطالبة التشديد على اللغة العربية أساساً لِسْني وَعَقَدِي (لغة القرآن)، أصبحت، بصورة تدريجية، غريبة لم تعد تُرفع في أي برنامج إصلاحي ولا يسمع صوتها تقريباً، فلم تتمسّك بالتعريب، بصورة منظمة وإيديولوجية تعبوية تنهل من القومية والدين، إلا فئات حزبية تقليدية محدودة من المدافعين الخُلّص عن “الهوية العربية الإسلامية” المُنْدَمجة، الذين استوحوا “السلفية الجديدة” كما قعّدها علال الفاسي نظرياً وسياسياً، وجعلوها رافداً وطنياً، على نحو ما كانت عليه في أواسط القرن العشرين، لمقاومة الحماية والبعث الإسلامي وإحياء اللغة العربية والمطالبة بالاستقلال، ولو بعد فترة، في الوقت نفسه. إلا أن تلك الفئات التقليدية سرعان ما تصالحت مع الوضع القائم على إثر الفشل الذي مُنيت به في تحقيق الإصلاح ومقاومة الاستبداد المطلق، فاندمجت تلقائياً في الاختيار الفرانكفوني العام بالصيغة البراغماتية التي أوْجَبَها الوضع السياسي المتحوّل في البلاد على إثر تدشين ما سمي “المسلسل الديمقراطي” (1975)، وعودة الحياة النيابية نسبياً، بعد انقطاعٍ سنوات، إلى “المجال الشرعي” الرسمي الذي يرعاه النظام السياسي ويتحكم في اختياراته.
المطالبة بالتعريب في مدى 50 سنة تقريباً، أصبحت، بصورة تدريجية، غريبة لم تعد تُرفع في أي برنامج إصلاحي
من أقوى التعبيرات المجسّدة للتخلي عن المطالبة بالتعريب، بالمعنى الذي قاله الجابري، أن التعليم في المغرب أصبح، منذ 1965، حقل تجارب لكثير من السياسات المتناقضة والتنظيمات المستنسخة التي أغرقته في ما يمكن نعته بـ”الإصلاح المستحيل”، الذي كان يُراد به الإفساد المؤكّد والتخلي المدروس عن الاختيارات الوطنية الإصلاحية، وخصوصاً عندما حوّلته هذه الاختيارات، في مراحل كثيرة من تقاطب الصراع بين السلطة والمعارضة، إلى ساحةٍ تُقَادُ فيها المظاهرات الطلابية والنقابية والسياسية، وتُطْرَحُ فيها، بالشعارات الراديكالية المناسبة أحياناً، أقوى المطالب التي تؤجّج الوضع السياسي نفسه، كذلك تثير لدى الفئات الاجتماعية المتضررة من الهيمنة اللغوية الفرنسية شعوراً عاماً بالسيطرة الأجنبية وبطبيعة الاستغلال الذي تآذاره هذه السيطرة، وهي فرنسية بالأساس، على الصعيد الاقتصادي.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى المطالبة بالتعريب بوصفه برنامجاً لغوياً أيضاً، ذا منزع تحريري، للتخلص من الهيمنة التي كانت للحماية الفرنسية على مقاليد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، وهي التي أيضاً طبعت المسار العام للتاريخ المغربي الحديث في علاقة بالغرب من زاوية المثاقفة والإنتاج الثقافي والفكري والتأثير اللغوي الشامل. كذلك يمكن النظر أيضاً إلى فشل المطالبة بالتعريب بوصفه انقلاباً على الأماني التي عبرت عنها “الحركة الوطنية” منذ بداية نشاطها السياسي في الثلاثينيات ضمن الانقلاب الشامل الذي أطبَقَ وطبَّقَتْه “حالة الاستثناء” في البلاد، وكان من نتائجه أنه رَكَّز السلطة المستبدة المطلقة ونَظَّم، بصورة جوهرية، تلك الاختيارات الاقتصادية والسياسية، والثقافية كذلك، التي سعت، في إطار ما سمي اقتصادياً “المغربة” (1974)، للاستحواذ الشامل، بطريقة مختلفة، بحكم الانقلابات العامة التي تحققت للنظام الدولي في إطار العولمة الشاملة، على مختلف المَقْدُورات ذات الطبيعة المستقلة التي تطوّرت في البلاد في خضم النضال الشعبي ضد الهيمنة الرسمية المطلقة وسطوتها الاستبدادية.
إن مقاومة التعريب، لأنه كان مرفوعاً في وجه الفرنسة الشاملة، أضحت رديفاً إيديولوجياً وسياسياً فعليا للحط من قيمة اللغة العربية
يمكن القول، في هذا الإطار، إن مقاومة التعريب، لأنه كان مرفوعاً في وجه الفرنسة الشاملة، أضحت رديفاً إيديولوجياً وسياسياً فعليا للحط من قيمة اللغة العربية (صارت تُدْعَى كلاسيكية، رغم التنصيص عليها في الدستور منذ 1962)، فتقلص دورها في التواصل، وأمست الكتابة بها، بصرف النظر عن القيمة الإبداعية لكتابها، مدعاةً للاحتقار والانتقاص المحمول على نرجسيّة تتغنى بالفرنسة والتجديد والعصرية والمثاقفة وما شابه. وهذا كله في محيطٍ تتعاظم فيه باستمرار ثلاثة مواقف متصادمة: واحد يعتبرها متجاوزة بسبب الجمود الذي خيّم عليها نتيجة لتخلفها عن مسايرة التطور التقني والعلمي والتكنولوجي الذي أصبح الصيغة المثلى، بما في ذلك على مستوى الشعار، للتطور وللنمو بغية تحقيق الازدهار والرقي واللحاق بالأمم السائرة في طريق النمو. والثاني بسبب السيطرة المطلقة للغة الفرنسية في مختلف مجالات الحياة والمعاملات وفي الإدارة العامة والخاصة للمؤسسات وللوزارات وعلى الصعيد الدبلوماسي إلخ، بوصفها لغة التداول والمراسلة والتخاطب والصفقات التجارية وغير التجارية والمخابرات، وهي في الآن نفسه، من خلال الشعور بالأهمية والقيمة الرمزية اللصيقة بالنموذج البرّاق المؤثر، لغة المستعمر القديم (وفي ثوبه الجديد) باني مقومات المغرب (الحديث) على أسس رأسمالية تبعية، وهي أيضاً لغة النخب المغربية الرسمية والوطنية التي أهلتها، في سياق التطور العام وبناءً على جدوى المصالح الفئوية الخاصة، لاحتلال مختلف المواقع الاقتصادية والتجارية والإدارية وفي تسيير شؤون الدولة والسيطرة والتحكم والاستغلال بشكل عام. والثالث في نتيجة منطقية لطبيعة اللغة نفسها من حيث التركيب والنحو والصرف، أي لغة مكتوبة ذات طبيعة عالمة في كل ما تنتجه من حيث الكفاية، مقارنة لها بغيرها في سوق اللغات، والأجنبية منها بخاصة، التي لها، على الصعيد المحلي، مواقع اقتصادية وثقافية تاريخية بارزة ومهمة ترشحها، على قاعدة تنافسية في علاقة بالعلوم والتطور العام، للقيام بالأدوار المطلوبة في نطاق العولمة الشاملة التي ترهن المجالات المتصلة كافة، أو المرتبطة، بها بالمصالح الكبرى التي تتوخاها من السيطرة الاقتصادية والتجارية الشاملة على الصعيد العالمي.
أما الأمازيغية التي اعتبرها محمد عابد الجابري قبل 50 سنة “لهجة”، وهي ثلاث (تَرِيفِيتْ، تمَازيغت، تَشِلْحِيت) يتكلّم بها قسم كبير من المغاربة في ثلاث مناطق جغرافية متباعدة نسبياً، وتتميز، باعتبارها “لهجة” في حد ذاتها، بالاختلاف النسبي في مفرداتها وقواعدها الصوتية والنحوية (رغم انتمائها إلى عائلة لغوية واحدة) فقد انتقلت، بفعل النضالات المدنية التي خاضها النشطاء الأمازيغيون، على اختلاف توجهاتهم وجمعياتهم طوال عقود، من المطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية، بناءً على التصوّر الهوياتي المختلف (عن العروبة والعربية والقومية العربية)، إلى تكوين رأي عام لعبت فيه بعض الأحزاب التقدمية دوراً مهماً في التطورات اللاحقة التي بَلْوَرَت حولها ما يمكن وصفه بـ”الذهنية الأمازيغية” التي ازدهرت فيها، وفي بعض جوانب هذا الازدهار ملامح ثقافية ذات أبعاد عنصرية ترافقت مع عشرية الأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية، شعارات ثقافية وسياسية وتاريخية متنوعة، ربما كان الهدف منها العمل على استكمال جوانب من “الهوية الإثنية” المبنيّة على أسس ثقافية واجتماعية تتقاطع مع الجغرافيا والدين، إلخ، وهي الراسخة في التراب المغربي منذ حقب بعيدة، ولعلها طُمست منذ القدم بسبب عوامل مختلفة.
جاء دستور 2011 في حمى هبّاتِ “الربيع العربي”، فَحَوَّل الأمازيغية إلى لغة رسمية معبّرة عن هوية مختلفة قوامها اللغة (تيفيناغ) والثقافة (تاريخ تَمَازْغَا)
جاء دستور 2011 في حمى هبّاتِ “الربيع العربي”، فَحَوَّل الأمازيغية، بعد تقاربات وإشارات اندرجت في السياسة العامة من حيث يسَّرت انتقال الملك، بناءً على “البَيْعَة”، إلى لغة رسمية معبّرة عن هوية مختلفة قوامها اللغة (تيفيناغ) والثقافة (تاريخ تَمَازْغَا)، لها ما يتطلبه البحث في سبيل نشرها وتعميمها رسمياً، متوجة بذلك مسيراً معقداً احتَشَدَت فيه مبرّرات شتى رُوعِيت فيها “طبيعة” التجربة المغربية في التغلب على المشكلات العويصة التي يبلورها التطوّر، أو يفرضها النضال، أي من خلال المساومة والتسليم بالأمر الواقع الذي يعني، في جوانب منه، الإقرار بحقائق الاختلاف بغية صوغ الاندماج (يمكن تأويله استدماجاً من الناحية النفسية أو أسلوب تدجين بالمنطق السياسي). أما العربية الدارجة، فقد تحوّلت، وأساساً من خلال اعتماد المصطلح اللساني المغشوش الذي يضفي “المعيارية” على العربية (Standardisation)، إلى “لغة” شاملة أقيمت حولها مناظرات، وأنجزت بها بعض الأطاريح، وظهر بها مبدعون في ساحة الأدب (الشعبي) من خلال الزجل (الشعر العامي) والقصة والحكاية وسواها، وربما كان الأهم من ذلك كله أنْ صدر حولها مُعْجَمٌ حديث، جَرْياً على العادة التي اتبعها بعض الفرنسيين العاملين في جهاز الحماية في التأليف لغير الناطقين بها، يسهل اعتمادها في فنون وأغراض مختلفة.
النتيجة النهائية لهذه التحولات أن المغرب على مستوى التعدّد اللساني أصبح أمام حقيقة كبرى: كيف يمكن صناعة “الوحدة الوطنية” والمذهبية التي يتغنّى بها الطامحون لبناء المجتمع الديمقراطي ودولة المؤسّسات اعتماداً على هويات متصادمة لها اختيارات متناقضة وخطابات تنبني على لغات مختلفة؟ بعبارة أخرى، ولو أنها إشكالية قديمة: بالديمقراطية الرشيدة عبر الإقرار بالتنوع والاختلاف في تساوق مع بناء دولة المؤسسات، أم بالاستبداد الذي يفرض التحكم والدَّمْج، حسب الظروف وطبائع الأمور، وليس له من أداة فعلية إلا القمع وفيه المصادرة؟

by | Sep 5, 2025 | أخبار العالم
كشفت إدارة شرطة ديربورن هايتس في ميشيغان عن شعار جديد للشرطة مصمم من قبل ضباطها، ويحتوي على اللغة العربية لأول مرة في البلاد.
وأكدت الشرطة لقناة “فوكس 2” يوم الأربعاء أن الإدارة لديها شارة اختيارية جديدة يُمكن للضباط ارتداؤها كجزء من زيهم الرسمي.
وتتضمن الشارة شعار ولاية ميشيغان في المنتصف، مع عبارة “شرطة ديربورن هايتس” مكتوبة باللغتين الإنكليزية والعربية.
تكريم لتنوع مجتمع ديربورن هايتس
ووفقًا للشرطة، صمّمت الضابطة إرميلي موردوك الشارة لتعكس تنوع المجتمع في المدينة وتكريمًا لهذا التنوع.
وبلغت نسبة سكان ديربورن هايتس من أصول شرق أوسطية أو شمال إفريقية 39% اعتبارًا من عام 2023، بينما يبلغون في ديربورن المجاورة حوالي 55%.
وكتبت إدارة الشرطة على فيسبوك: “نفخر بإبداع الضابط مردوك وتفانيها في مساعدة قسمنا على تمثيل مَن نخدمهم بشكل أفضل”.
وأضافت: “يخدم ضباطنا جميع أفراد مجتمعنا بفخر، وهذا التصميم الجديد هو وسيلة أخرى نواصل من خلالها الاحتفاء بالثقافات الغنية التي تُميّز مدينتنا”.
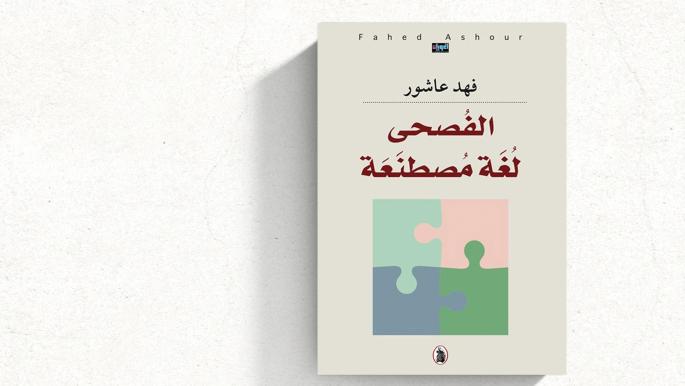
by | Sep 2, 2025 | أخبار العالم
لم تنه التعديلات التي أجراها طه حسين على كتابه “في الشعر الجاهلي” (1926)، الجدل حول آرائه الواردة في الطبعة الأولى في القصائد التي تُنسب إلى العرب ما قبل الإسلام، كونها منحولة تمثّل حياة المسلمين، ولا تعبّر عن نظرة أسلافهم الفكرية والدينية ولا تأخذ مبنى لغتهم القديمة. تركت تلك الخلاصات باب الشك مفتوحاً، رغم تعدّد الاعتراضات عليها، وهو ما يعيد طرحه الباحث فهد عاشور في دراسة مستفيضة لحوالي مئة ألف نقش أثري يعود أقدمها، إلى القرن الثامن قبل الميلاد.
تمثّل هذه النقوش صدمة معرفية ضمن مستويات متعدّدة، إذ تمّ العثور عليها في الباديتين السورية والأردنية (وأجزاء محدودة من شمال غرب السعودية) قبل انتشارها بعد فترة متأخرة نسبياً إلى بقية أنحاء الجزيرة العربية، وأنها كُتبت بلهجات عربية قديمة مختلطة أو متأثّرة بالآرامية أو لهجات بدوية لا يزال بعضها حيّاً حتى اليوم، بالإضافة إلى الكتابة بلهجات شديدة الشبه باللهجات العامية المعاصرة في بلاد الشام مع بعض السمات الفصيحة، كما تبيّنها أولى البرديات الإسلامية، وأنه لم يوجد فيها جميعاً بيتُ شعرٍ جاهلي واحد كما تمّ تدوينه في عهد العباسيين.
يفكّك عاشور في كتابه “الفصحى.. لغة مصطنعة” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2025)، جملة مسلّمات تتعلّق بمفاهيم الفصاحة، التي يراها اختراعاً عراقياً محضاً لا صلة لسكّان جزيرة العرب بها، وأن مفردة العرب تعني الحَرْف ولم تعن جماعة إثنية، وكيف أن العربية تحوّلت اصطلاحاً على يد النحاة في القرن الـ 4 هـ/10 م، من “اللغة بمعناها العام” إلى “اللغة المنسوبة حصراً للعرب”.
شعر نبطي تمّت فصحنته
يبدو لافتاً العثور على نقشَيْ “ترنيمة الشمس” الذي يثبت وجود الشعر الحميري في جنوب الجزيرة العربية، و”عين عبده” الذي يثبت أيضاً وجود الشعر النبطي في شمالها، بينما لم تُظهر الأدلة الكتابية وجود الشعر الجاهلي الذي تفترض المصادر المتأخرة أنه كُتب في الفترة نفسها. ويتساءل المؤلّف أيضاً لماذا اختفى الشعر الجاهلي بصورة مفاجئة، تماماً كما ظهر، وكأن حياة البادية والرحلة والأطلال وتقاليد الفروسية انتهت من جزيرة العرب، بخلاف ما تقول المصادر التاريخية.
يرى الفصاحة اختراعاً عراقياً لا صلة لسكّان جزيرة العرب به
وهنا، تحضر فرضية الكتاب بأن الشعر الجاهلي استُدعيَ بوصفه الممثل الوحيد للغة العربية القديمة، لإثبات مشروعية القواعد اللغوية التي وُضعت في القرن الهجري الثاني 8 م، وتفسير القرآن، وتاريخ العرب قبل الإسلام، وبعد أقل من قرن لم يعد لهذا الشعر أية وظيفة واختفى من كتب النحو والأدب والتفسير والتاريخ، بشكل مفاجئ كما ظهر. لكن المؤلف لا يفترض اختلاق آلاف الأبيات من الشعر الجاهلي في فترة زمنية محدودة، وأن يكون هذا الشعر المكتمل من حيث البناء والوزن والمواضيع اخترع من العدم، دون وجود أصل شعري متقدّم عليه. ولحل هذا اللغز، يقول إن القبائل العربية نظمت الشعر بلهجاتها البدوية ودوّنت بعضه بها، ومع ظهور الازدواجية اللغوية مع بداية عصر التدوين، تم نقل الشعر من اللغة العامية إلى اللغة الفصحى، حيث أعاد رواة الشعر والإخباريون واللغويون في العراق تحويل الشعر النبطي بمواضيعه وأوزانه إلى شعر منظوم بالفصحى، كونهما يتطابقان في المعنى والصورة ويختلفان باللغة من حيث البناء والإعراب.
ما عدا الاستشهاد بالنقوش الأثرية التي تدحض وجود نصوص فصحى قبل العباسيين، تظلّ تساؤلات الكتاب على أهميتها محل نقاش مفتوح، ومنها لماذا لم تنجب الجزيرة العربية شعراء بعد انتهاء العصر الأموي وصمتت حتى العصر الحالي، وهو يناقض الوقائع التي تشير إلى نظم الشعر النبطي لأكثر من ألفي عام، لكن توقّف تفصيحه أدى إلى حجبه بعد أن قامت هذه العملية بدورها التاريخي.
تصحيح مصطلحات
مفارقة لغوية قادت عاشور إلى تأليفه كتابه، تعود إلى أواخر سنة 2013، مع سيطرة جماعات مسلحة على بلدة معلولا السورية التي لا تزال ناطقة مع قرى أخرى بالآرامية، مترافقاً مع خروج الناطقين باللغات المهرية والشحرية في اليمن على وسائل الإعلام في سياق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي. ليطرح تساؤله كيف استطاعت هذه اللغات النادرة أن تحافظ على بقائها في المنطقة؟ ولم يتهيأ لها ما حظيت به اللغة الفصحى من أسباب التفوق، فهي لغة الشعر والأدب، ولغة الكتابة، ولغة دولة الخلافة، لكن الناطقون بها اختفوا من المدن منذ القرن الثاني الهجري كما يذكر الجاحظ، ومن البوادي مثلما يروي ابن جني!
عبّرت الفصحى عن صناعة هوية إثنية للعرب ضمن صراعهم الشعوبي
مسألة أخرى تتعلّق باللحن (أخطاء الإعراب)، إذ لا يجد وجاهة للتفسير الذي يسلّم به اللغويون، ومردّه اختلاط العرب بالشعوب المسلمة الناطقة بلغات أخرى، وهو أمر لا ينطبق على غيرها من اللغات العالم، التي لم يفقد الناطقون بها لسانهم أو يفسد، إنما يؤدي اختلاطهم إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة، بحسب الكتاب الذي يورد ما يسميه مجموعة مزاعم أسطورية، قدمتها كتابات العصر العباسي، متمثلةً بأن اليمن مسقط رأس العرب التاريخي، بينما تفنّد النقوش القديمة هذا الزعم حيث اللغات اليمنية القديمة لا صلة لها بالأبجديات العربية، وأن جزيرة العرب هي موطن العرب وحدهم منذ أقدم العصور وأنهم عاشوا في عزلة عن الشعوب المجاورة. لذلك حافظوا على نقاء لغتهم الفصحى، بينما تعكس اللغات والخطوط التي دوّن بها قرابة ألف نقش على امتداد طريق التجارة بين جنوب الأردن وشمال الحجاز، بين القرنين الأول والثالث الميلادي، درجة كبيرة من التنوع اللغوي تركتها قوافل المسافرين باليونانية والآرامية والنبطية والتدمرية والصفاوية والثمودية وغيرها مما تبطل أساس فكرة العزلة.
وتكشف نتائج التحليل السابق الارتباط الوثيق بين ظهور القرآن وولادة الأبجدية العربية التي لم يُكتب بها قبل ذلك عبارة واحدة، وكيف “قدّم النص المقدس حلولاً لمشكلات لغوية وكتابية مزمنة، عانت منها القبائل العربية على مدى زمني يقدّر بحوالي 1400 عام سبقت نزوله”. وفي إشارة تحمل معناها، يلفت الكتاب إلى لفظة الفصاحة ومشتقاتها التي لم تعرفها النقوش العربية القديمة مطلقاً، ولا وجود لعبارات اللغة الفصحى واللسان الفصيح في جميع الأدلة الكتابية قبل الإسلام، ويرجع أقدم استخدام موثوق للجذر (ف ص ح) إلى القرآن.
القرآن والكتابة
بالنظر إلى عدم وجود أبجدية معيارية موحدة لدى العرب، اهتم القرآن بموضوع الكتابة، ليكون تأسيس دين كتابي أمراً متحققاً في مجتمع تنتشر فيه ديانات وثنية تقوم على الشفاهية، ودعوة لهم إلى “الوحدة في كل شيء تقريباً: الإله، الدين، الكتاب، الدولة، والمجتمع”. يتوقف الكِتاب عند ذكر كلمة “عربي” في القرآن في 11 موضعاً، استخدمت فيها جميعاً وصفاً للقرآن نفسه، وتعني الحرف ولا تشير إلى جماعة إثنية، وهو يوجّه خطابه إلى العرب بل لجميع الناس.
في القرون الهجرية الثلاثة، يوضّح عاشور أن البرديات التي عُثر عليها لم تكتب بالفصحى بل لغة يسمّيها الدارسون “العربية الوسطى” وتجمع بين السمات القياسية (الفصحى) والعامية، مع سمات من نوع ثالث ليست قياسية ولا عامية، والتي ظلّت مستخدمة حتى اليوم، في التدريس والإعلام والخطب السياسية، والمراسلات، والكتابات الأدبية وغيرها.
ويخلص إلى أن الفصحى نجحت في أن تكون لغة كتابة تستخدمها النخبة، التي اعتبرتها مسألة صناعة هوية إثنية للعرب ضمن صراعهم الشعوبي مع بقية شعوب دولة الخلافة، لكنها فشلت فشلاً تاماً في التحول إلى لغة طبيعية، وحتى يمتلك العرب اليوم لغة عربية حديثة عليهم أن يمتلكوا رؤية حديثة للغة، تناسب العصر، وعلماً حديثاً يمكنهم من دراسة لغتهم، وفهمها بعيداً عن التصورات الأيديولوجية.
ينبّه المؤلف إلى أن هناك احتمالاً ضئيلاً لتغيير الفرضية التي يتبناها حول غياب الفصحى عن العرب أربعة عشر قرناً قبل الإسلام، لكن حقل النقاش هذا يخصّ اللغويين المتخصصين، وليس العامة الذين قد يرفضون كلّ ما جاء به الكتاب لمخالفته عقائد ومسلّمات رسخت لقرون، لكن الحديث عن سبل النهوض بالعربية اليوم في خاتمة الكتاب لتكون لغة علم ومعرفة ربما يشكّل مدخلاً ضرورياً يهمّ جميع الناطقين بها.