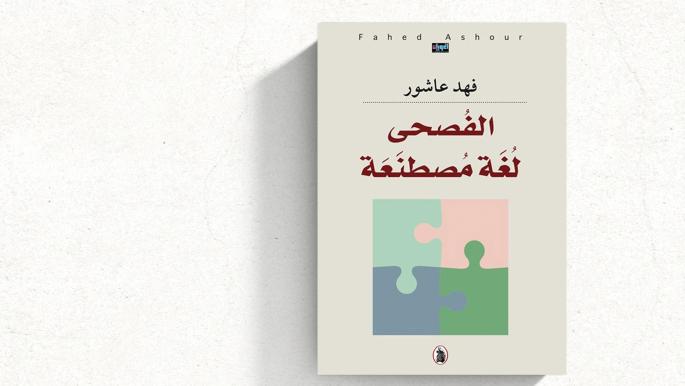
هل اخترع العباسيون الفصحى؟
لم تنه التعديلات التي أجراها طه حسين على كتابه “في الشعر الجاهلي” (1926)، الجدل حول آرائه الواردة في الطبعة الأولى في القصائد التي تُنسب إلى العرب ما قبل الإسلام، كونها منحولة تمثّل حياة المسلمين، ولا تعبّر عن نظرة أسلافهم الفكرية والدينية ولا تأخذ مبنى لغتهم القديمة. تركت تلك الخلاصات باب الشك مفتوحاً، رغم تعدّد الاعتراضات عليها، وهو ما يعيد طرحه الباحث فهد عاشور في دراسة مستفيضة لحوالي مئة ألف نقش أثري يعود أقدمها، إلى القرن الثامن قبل الميلاد.
تمثّل هذه النقوش صدمة معرفية ضمن مستويات متعدّدة، إذ تمّ العثور عليها في الباديتين السورية والأردنية (وأجزاء محدودة من شمال غرب السعودية) قبل انتشارها بعد فترة متأخرة نسبياً إلى بقية أنحاء الجزيرة العربية، وأنها كُتبت بلهجات عربية قديمة مختلطة أو متأثّرة بالآرامية أو لهجات بدوية لا يزال بعضها حيّاً حتى اليوم، بالإضافة إلى الكتابة بلهجات شديدة الشبه باللهجات العامية المعاصرة في بلاد الشام مع بعض السمات الفصيحة، كما تبيّنها أولى البرديات الإسلامية، وأنه لم يوجد فيها جميعاً بيتُ شعرٍ جاهلي واحد كما تمّ تدوينه في عهد العباسيين.
يفكّك عاشور في كتابه “الفصحى.. لغة مصطنعة” (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2025)، جملة مسلّمات تتعلّق بمفاهيم الفصاحة، التي يراها اختراعاً عراقياً محضاً لا صلة لسكّان جزيرة العرب بها، وأن مفردة العرب تعني الحَرْف ولم تعن جماعة إثنية، وكيف أن العربية تحوّلت اصطلاحاً على يد النحاة في القرن الـ 4 هـ/10 م، من “اللغة بمعناها العام” إلى “اللغة المنسوبة حصراً للعرب”.
شعر نبطي تمّت فصحنته
يبدو لافتاً العثور على نقشَيْ “ترنيمة الشمس” الذي يثبت وجود الشعر الحميري في جنوب الجزيرة العربية، و”عين عبده” الذي يثبت أيضاً وجود الشعر النبطي في شمالها، بينما لم تُظهر الأدلة الكتابية وجود الشعر الجاهلي الذي تفترض المصادر المتأخرة أنه كُتب في الفترة نفسها. ويتساءل المؤلّف أيضاً لماذا اختفى الشعر الجاهلي بصورة مفاجئة، تماماً كما ظهر، وكأن حياة البادية والرحلة والأطلال وتقاليد الفروسية انتهت من جزيرة العرب، بخلاف ما تقول المصادر التاريخية.
يرى الفصاحة اختراعاً عراقياً لا صلة لسكّان جزيرة العرب به
وهنا، تحضر فرضية الكتاب بأن الشعر الجاهلي استُدعيَ بوصفه الممثل الوحيد للغة العربية القديمة، لإثبات مشروعية القواعد اللغوية التي وُضعت في القرن الهجري الثاني 8 م، وتفسير القرآن، وتاريخ العرب قبل الإسلام، وبعد أقل من قرن لم يعد لهذا الشعر أية وظيفة واختفى من كتب النحو والأدب والتفسير والتاريخ، بشكل مفاجئ كما ظهر. لكن المؤلف لا يفترض اختلاق آلاف الأبيات من الشعر الجاهلي في فترة زمنية محدودة، وأن يكون هذا الشعر المكتمل من حيث البناء والوزن والمواضيع اخترع من العدم، دون وجود أصل شعري متقدّم عليه. ولحل هذا اللغز، يقول إن القبائل العربية نظمت الشعر بلهجاتها البدوية ودوّنت بعضه بها، ومع ظهور الازدواجية اللغوية مع بداية عصر التدوين، تم نقل الشعر من اللغة العامية إلى اللغة الفصحى، حيث أعاد رواة الشعر والإخباريون واللغويون في العراق تحويل الشعر النبطي بمواضيعه وأوزانه إلى شعر منظوم بالفصحى، كونهما يتطابقان في المعنى والصورة ويختلفان باللغة من حيث البناء والإعراب.
ما عدا الاستشهاد بالنقوش الأثرية التي تدحض وجود نصوص فصحى قبل العباسيين، تظلّ تساؤلات الكتاب على أهميتها محل نقاش مفتوح، ومنها لماذا لم تنجب الجزيرة العربية شعراء بعد انتهاء العصر الأموي وصمتت حتى العصر الحالي، وهو يناقض الوقائع التي تشير إلى نظم الشعر النبطي لأكثر من ألفي عام، لكن توقّف تفصيحه أدى إلى حجبه بعد أن قامت هذه العملية بدورها التاريخي.
تصحيح مصطلحات
مفارقة لغوية قادت عاشور إلى تأليفه كتابه، تعود إلى أواخر سنة 2013، مع سيطرة جماعات مسلحة على بلدة معلولا السورية التي لا تزال ناطقة مع قرى أخرى بالآرامية، مترافقاً مع خروج الناطقين باللغات المهرية والشحرية في اليمن على وسائل الإعلام في سياق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي. ليطرح تساؤله كيف استطاعت هذه اللغات النادرة أن تحافظ على بقائها في المنطقة؟ ولم يتهيأ لها ما حظيت به اللغة الفصحى من أسباب التفوق، فهي لغة الشعر والأدب، ولغة الكتابة، ولغة دولة الخلافة، لكن الناطقون بها اختفوا من المدن منذ القرن الثاني الهجري كما يذكر الجاحظ، ومن البوادي مثلما يروي ابن جني!
عبّرت الفصحى عن صناعة هوية إثنية للعرب ضمن صراعهم الشعوبي
مسألة أخرى تتعلّق باللحن (أخطاء الإعراب)، إذ لا يجد وجاهة للتفسير الذي يسلّم به اللغويون، ومردّه اختلاط العرب بالشعوب المسلمة الناطقة بلغات أخرى، وهو أمر لا ينطبق على غيرها من اللغات العالم، التي لم يفقد الناطقون بها لسانهم أو يفسد، إنما يؤدي اختلاطهم إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة، بحسب الكتاب الذي يورد ما يسميه مجموعة مزاعم أسطورية، قدمتها كتابات العصر العباسي، متمثلةً بأن اليمن مسقط رأس العرب التاريخي، بينما تفنّد النقوش القديمة هذا الزعم حيث اللغات اليمنية القديمة لا صلة لها بالأبجديات العربية، وأن جزيرة العرب هي موطن العرب وحدهم منذ أقدم العصور وأنهم عاشوا في عزلة عن الشعوب المجاورة. لذلك حافظوا على نقاء لغتهم الفصحى، بينما تعكس اللغات والخطوط التي دوّن بها قرابة ألف نقش على امتداد طريق التجارة بين جنوب الأردن وشمال الحجاز، بين القرنين الأول والثالث الميلادي، درجة كبيرة من التنوع اللغوي تركتها قوافل المسافرين باليونانية والآرامية والنبطية والتدمرية والصفاوية والثمودية وغيرها مما تبطل أساس فكرة العزلة.
وتكشف نتائج التحليل السابق الارتباط الوثيق بين ظهور القرآن وولادة الأبجدية العربية التي لم يُكتب بها قبل ذلك عبارة واحدة، وكيف “قدّم النص المقدس حلولاً لمشكلات لغوية وكتابية مزمنة، عانت منها القبائل العربية على مدى زمني يقدّر بحوالي 1400 عام سبقت نزوله”. وفي إشارة تحمل معناها، يلفت الكتاب إلى لفظة الفصاحة ومشتقاتها التي لم تعرفها النقوش العربية القديمة مطلقاً، ولا وجود لعبارات اللغة الفصحى واللسان الفصيح في جميع الأدلة الكتابية قبل الإسلام، ويرجع أقدم استخدام موثوق للجذر (ف ص ح) إلى القرآن.
القرآن والكتابة
بالنظر إلى عدم وجود أبجدية معيارية موحدة لدى العرب، اهتم القرآن بموضوع الكتابة، ليكون تأسيس دين كتابي أمراً متحققاً في مجتمع تنتشر فيه ديانات وثنية تقوم على الشفاهية، ودعوة لهم إلى “الوحدة في كل شيء تقريباً: الإله، الدين، الكتاب، الدولة، والمجتمع”. يتوقف الكِتاب عند ذكر كلمة “عربي” في القرآن في 11 موضعاً، استخدمت فيها جميعاً وصفاً للقرآن نفسه، وتعني الحرف ولا تشير إلى جماعة إثنية، وهو يوجّه خطابه إلى العرب بل لجميع الناس.
في القرون الهجرية الثلاثة، يوضّح عاشور أن البرديات التي عُثر عليها لم تكتب بالفصحى بل لغة يسمّيها الدارسون “العربية الوسطى” وتجمع بين السمات القياسية (الفصحى) والعامية، مع سمات من نوع ثالث ليست قياسية ولا عامية، والتي ظلّت مستخدمة حتى اليوم، في التدريس والإعلام والخطب السياسية، والمراسلات، والكتابات الأدبية وغيرها.
ويخلص إلى أن الفصحى نجحت في أن تكون لغة كتابة تستخدمها النخبة، التي اعتبرتها مسألة صناعة هوية إثنية للعرب ضمن صراعهم الشعوبي مع بقية شعوب دولة الخلافة، لكنها فشلت فشلاً تاماً في التحول إلى لغة طبيعية، وحتى يمتلك العرب اليوم لغة عربية حديثة عليهم أن يمتلكوا رؤية حديثة للغة، تناسب العصر، وعلماً حديثاً يمكنهم من دراسة لغتهم، وفهمها بعيداً عن التصورات الأيديولوجية.
ينبّه المؤلف إلى أن هناك احتمالاً ضئيلاً لتغيير الفرضية التي يتبناها حول غياب الفصحى عن العرب أربعة عشر قرناً قبل الإسلام، لكن حقل النقاش هذا يخصّ اللغويين المتخصصين، وليس العامة الذين قد يرفضون كلّ ما جاء به الكتاب لمخالفته عقائد ومسلّمات رسخت لقرون، لكن الحديث عن سبل النهوض بالعربية اليوم في خاتمة الكتاب لتكون لغة علم ومعرفة ربما يشكّل مدخلاً ضرورياً يهمّ جميع الناطقين بها.
