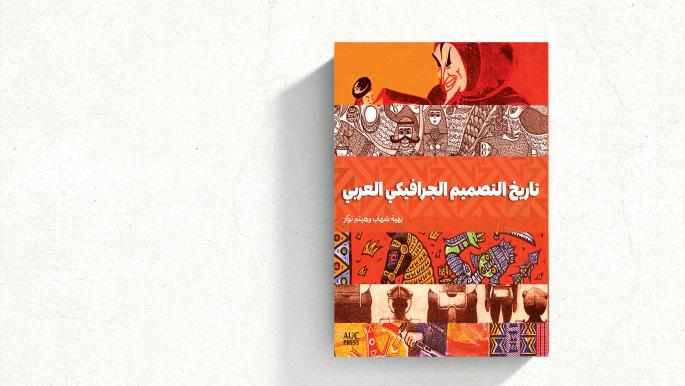إصدارات.. نظرة أولى
في زاوية “إصدارات.. نظرة أولى” نقف على آخر ما تصدره أبرز دُور النشر والجامعات ومراكز الدراسات في العالم العربي وبعض اللغات الأجنبية، ضمن مجالات متعدّدة تتنوّع بين الفكر والأدب والتاريخ، ومنفتحة على جميع الأجناس، سواء الصادرة بالعربية أو المُترجمة إليها.
هي تناولٌ أوّل لإصدارات نقترحها على القارئ العربي بعيداً عن دعاية الناشرين أو توجيهات النقّاد. قراءة أُولى تمنح مفاتيح للعبور إلى النصوص.
مختارات هذا الأسبوع تتضمن كتباً في الأدب، والسياسية، والتراث، وغيرها.
■■■
عن دار الساقي، صدر كتاب “أقوى من الدول: 6 مليارديرات غيّروا وجه العالم” للكاتبة والصحافية الفرنسية كريستين كيرديلان، بترجمة أنطوان سركيس. يكشف العمل كيف تحوّل ستة من كبار رجال الأعمال إلى قوة تتجاوز الحكومات وتتحكّم بمصير البشرية. فبيل غيتس يسيطر على الصحة العالمية، وإيلون ماسك يرسم ملامح الإنترنت الفضائي وفق مصالحه، ومارك زوكربيرغ يهدد الأجيال الشابة بخوارزميات منصاته. أما جيف بيزوس فيخطّط لحياة بشرية في كبسولات عملاقة، بينما يعمل لاري بيج وسيرغي برين على دمج الإنسان بالآلة في سباقٍ مع الموت.
يتناول كتاب “الاقتصاد الإبداعي والثقافة: التحديات والتحولات ومستقبل الصناعات الإبداعية”، الذي يصدر عن دار نينوى، من تأليف جون هارتلي، وين وين، وهنري سيلينغ لي، وترجمة سامي حسن عرار، مفهوم الاقتصاد الإبداعي بديلاً تنموياً يعيد الاعتبار للثقافة والمعرفة والابتكار في تشكيل المستقبل. لا يكتفي المؤلفون بعرض سرد تقليدي لمسار الصناعات الإبداعية، بل يقدمون قراءة نقدية وتطورية تعيد رسم العلاقة بين الثقافة والاقتصاد. ويطرح الكتاب مفاهيم جديدة مثل “السيميوسفير” و”الفرادة الثقافية” و”الإنتاجية الدقيقة” لفهم التحولات المعاصرة.
ضمن سلسلة “ترجمان”، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “ضدّ الليبرالية الرمزية: دعوة إلى علم اجتماع تحاوري”، من تأليف ساري حنفي، وترجمة ياسر الزيات. يقع الكتاب في 344 صفحة، يتضمن سبعة فصول، ويتناول كيفية تشكّل ليبرالية رمزية تنتهك مبادئ الليبرالية السياسية، مع الدعوة إلى مشروع ليبرالي تحاوري. يمزج المؤلف الفلسفة السياسية بالأخلاقية بالنقد السوسيولوجي، ليقدّم مفهوم “الليبرالية الرمزية”، مع توضيح التناقض الذي يتمثل في أفراد يتبنّون المبادئ الليبرالية الكلاسيكية ويتصرّفون بطرائق غير ليبرالية سياسياً.
عن دار أبعاد للنشر والتوزيع، صدر كتاب “الأقليات ركن يتصدع بصمت: الموحدون الدروز”، للباحث حسام نصار، وهو دراسة إنثروسوسيولوجية في الثقافة الأساسية لمعتقداتهم الدينية، وموروثاتهم الاجتماعية، وتأثيرها على سلوكهم الجمعي. يناقش فيه الباحث مفاهيم الدين والتدين، بالتركيز على البعد الاجتماعي في تشكيل الخصوصية الثقافية لهذه الجماعة، كما يدرس علاقاتها مع الجماعات الأخرى داخل التركيبة اللبنانية، ويفكك العلاقة بين الهوية الطائفية والعقيدة الدينية، ويشرح نتائج هذه العلاقة في الواقع، بأبعاده الاجتماعية والسياسية.
موسيقار وموظّف بلديّة، وعاشق للمتعة، هكذا يتمثّل المؤرّخ والملحّن والفوتوغرافي الفلسطيني واصف جوهريّة في كتاب الفرنسية من أصل إيطالي لورا أولنيتي “كنتُ ملكاً في القدس” الصادر عن أكت سود. يقدّم العمل جوهرية بوصفه شاهداً على زمن كان فيه المسيحيون واليهود والمسلمون جميعاً يلقّبون أنفسهم بـ”أهل الأرض المقدّسة”، سكان مدينة “تختلط فيها وتتناول جميع لهجات البحر المتوسط معاً”. على أوتار العود، يعيد واصف إحياء صوت القدس في العقود الأولى من القرن العشرين، بنكهاتها وألوانها الزاهية المنسية، بعيداً عن الصورة النمطية للصراع عليها.
عن دار جبرا للنشر والتوزيع، صدر كتاب “الوظائف والأثر الدلالي في النص الكنفاني” للشاعر والناقد العراقي علاء حمد. يبحث الكتاب، الواقع في 246 صفحة، بالمعنى والتأثير لواحد من أهم الكتّاب المتجذرين في الثقافة الفلسطينية: غسان كنفاني، وبالأخص أعماله الروائية، بالاعتماد على مفاهيم مثل التشريح الكتابي وتوظيف الاستعارات والمبدأ الإشاري. من إصدارات حمد النقدية: “المحسوس وثقافة المتخيل”، والكائن النصي.. اتجاهات النص الحديث، الرمزية، السريالية”، و”أمام جدلية النص.. الجدل الحجاجي، تفعيل التأويل، مبدأ السبب التفاعلي”.
“العالم عند أول ضوء: تاريخ جديد لعصر النهضة”، عنوان الكتاب الذي صدر للباحث بيرند روك عن منشورات جامعة برنستون. يُظهر المؤلف أن إعادة اكتشاف المعرفة القديمة، بما في ذلك علوم العالم العربي في العصور الوسطى، لعبت دوراً حاسماً في تشكيل بدايات الحداثة الغربية. كما يوضح أن عصر النهضة ظهر في جزء من أوروبا حين شكلت الدول والمدن المتنافسة مجتمعات منفتحة نسبياً، وجاء معظم المبدعين في ذلك العصر، من ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو إلى كوبرنيكوس وغاليليو، من الطبقة الوسطى، الذين رسخوا بذور التفكير النقدي والدولة الحديثة والديمقراطية.
عن دار راية للنشر والترجمة، صدرت الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر والناقد اللبناني بول شاوول. تشتمل الأعمال على المجموعات الشعرية ابتداءً من مجموعته الأولى “أيها الطاعن في الموت”، ومروراً بـ”الهواء الشاغر” و”بلا أثر يذكر”، وصولاً إلى “ذلك الجسد”، آخر أعمال الشاعر المنشورة. علماً أن شاوول عمِل في الصحافة الثقافية اللبنانية، وترجم عشرات النصوص الإبداعية لأشهر الكتّاب والشعراء من مختلف الثقافات، أوروبية وآسيوية، بالإضافة إلى إصداره عدداً من الأنطولوجيات الموسوعية، بينها “مختارات الشعر الفرنسي 1900-1985”.