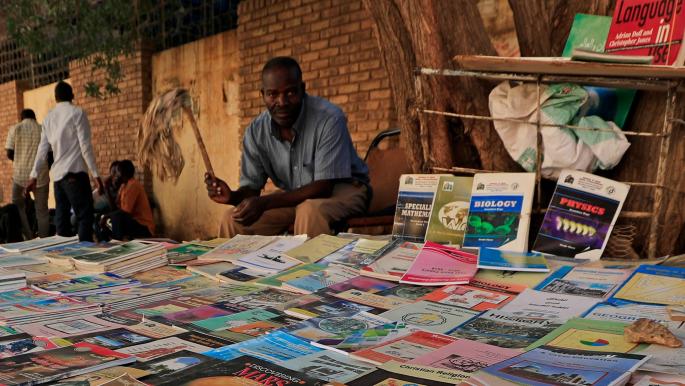في زمنٍ تتحول فيه الثقافة إلى أولى ضحايا الحرب في السودان، يستعيد مشروع “حديقة الكلمات” دور السرد في تشكيل الهوية الجمعية. الموقع الإلكتروني الذي أطلقه الكاتب أيمن هاشم مطلع العام الجاري، يتعامل مع القصة القصيرة السودانية بوصفها وسيلة لتوثيق اللحظة التاريخية وإعادة تخيل المستقبل.
يمثل المشروع استمرارية لمبادرات عديدة ظهرت في السنوات الماضية، مثل مؤسسة “جيل جديد” تلك المجموعة الشبابية التي تأسست عام 2007، ونظّمت العديد من ورش ومسابقة الكتابة التي قدّمت أصواتاً جديدة للمشهد القصصي في البلاد، وكان لها دورها خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كانون الأول/ كانون الأول 2018.
مبادرات خارج المؤسسة التقليدية
العديد من كتّاب الموقع الجديد بمن فيهم مؤسّسه، كان لهم مشاركات في تلك الفترة التي شهدت ازدهاراً قصصياً ملحوظاً، ومثلما شكّلت جوائز الطيب صالح للقصة القصيرة آنذاك إحدى الآليات التي ساعدت في اكتشاف المواهب الجديدة، تسعى “حديقة الكلمات” إلى ترسيخ آليات جديدة بعيداً عن المؤسسات التقليدية التي أصبحت عاجزة عن مواكبة التحولات.
يجمع المشروع بين توثيق الحكايات الشعبية والأمثال القديمة إلى جانب النصوص القصصية، بأحدث وسائل النشر الرقمي، وهذا المزج ليس تقنياً فحسب، بل يتجلى في المضمون نفسه، حيث تتعايش النصوص التي تستلهم الموروث مع أخرى تعبّر عن هموم الجيل الحالي. وهنا، تثبت القصة القصيرة مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف، وهو ما يذكّر بستينيات القرن الماضي عندما استوعبت القصة تأثيرات الحداثة في السودان من دون أن تنفصل عن الواقع المحلي.
يمثل المشروع استمرارية لمبادرات عديدة ظهرت في السنوات الماضية
لا يواجه “حديقة الكلمات” تحديات تتعلّق بالجانب التقني أو حتى بنقص المواد الإبداعية، بل بكيفية الحفاظ على استمرارية المشروع في بيئة تتسم بعدم الاستقرار، فتاريخ الصحافة والمجلات الأدبية يشير إلى توقف العديد منها بسبب ظروف مادية أو سياسية، ومنها صحيفة “القصة السودانية” التي تأسست عام 2009 ولم تستمر طويلاً، رغم الأثر الكبير الذي تركته.
هل يمكن للرقمنة أن توفر حلاً لمشكلة الاستدامة هذه؟ الإجابة ليست بسيطة، فالمشاريع الإلكترونية تواجه تحدياتها الخاصة، بدءاً من مشكلة التمويل ووصولاً إلى صعوبة الوصول في مناطق تنقطع فيها الإنترنت بشكل متكرر، لكنه يمثل حلقة في سلسلة طويلة من محاولات إبقاء الثقافة السودانية حيّة رغم كل الظروف.
تاريخ ومحطّات
هذا التوجه ليس جديداً على الأدب السوداني، فمنذ خمسينيات القرن الماضي مع صدور أولى المجموعات القصصية مثل “غادة القرية” (1954) لعثمان علي نور، كانت الكتابة السردية دوماً مرتبطة بسياقها الاجتماعي والسياسي، ضمن منعطفات أساسية منها إنشاء مجلّتي “النهضة” و”الفجر” في الثلاثينيات، ومساهمتها في دعم الحركة الأدبية الناشئة من خلال نشر نصوص العديد من الأدباء الذين أصبحت لهم مساهماتهم في العقدين اللاحقين.
ثم ظهرت في كانون الثاني/ كانون الأول 1960 مجلة “القصة” التي ركّزت على الفن القصصي من خلال فتح الباب لمشاركة كتاب مكرسين وآخرين جدد في نشر نصوصهم، وكذلك المتابعة النقدية لها، ورغم أن المجلة توقفت بعد عام ونصف العام لأسباب مالية، بعد إصدار 17 عدداً فقط، غير أنها تركت أثراً واضحاً في حداثة القصة القصيرة.
مع اختلاف الواقع بين حقبتين، يتشابه حضور “حديقة الكلمات” باعتباره فضاء يجمع ما تفرّق، ويمكن للقصة القصيرة أن تعبر خطوط القتال وتصل إلى قراء لم يعودوا قادرين على الوصول إلى المكتبات أو المراكز الثقافية. التجربة تذكّر بجريدة “الصراحة” في الخمسينيات التي ساهمت في نشر الأعمال القصصية في سياق مقاومة الاستعمار في وقت كانت فيه وسائل النشر محدودة، بينما تقارب القصة السودانية مآزق أكبر تتعلق بالانقسام وإعادة بناء الدولة والمجتمع.